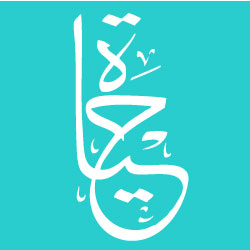إذا صحت الأنباء التي تحدثت عن تشجيع هيلاري كلينتون للرئيس محمد مرسي على إصدار الإعلان الدستوري، فإن ذلك يجب ألا يذكرنا إلا بتشجيع ابريل غلاسبي لصدام حسين على اجتياح الكويت. وإذا ما خرجنا من التفاصيل: من سار باتجاه التحرير ومن سار باتجاه الاتحادية، من أقر الدستور بسرعة قياسية ليست إلا سلقا لهذه العملية التاريخية، ومن قرر مقاطعة الاستفتاء ثم عاد فقرر المشاركة فيه، من يدعي أن عمليات التصويت مشوبة بمخالفات أساسية وقانونية، ومن يدعي أنها سارت في جو ديمقراطي يتعلل بالأكثرية، من هرع لتلبية شعار إنقاذ الشريعة وكأن الآخرين كفار أو ضد الشريعة، ومن وقف مدافعا عن الدولة المدنية حيث يختلط القومي باليساري بالليبرالي – باختصار إذا ما خرجنا من ردات الفعل وردات الفعل عليها، فإننا لا نستطيع أن ننظر إلى التصعيد الذي تعيشه الدولة العربية الكبرى إلا بمنظار القلق، القلق من مؤامرة لن تتبدى ملامحها وآثارها إلا على المدى البعيد، ولا فرق فيمن ينفذ أو من يستدرج الاستفزاز أو يلبيه، لا فرق في من يمتلك القرار أو من يشجعه على التمسك به استفزازا وفي من يحول اعتراضه إلى أعمال عنف، اللهم إلا فرقا واحدا يتمثل في أن من يمتلك القرار يمتلك معه القدرة على نزع الصواعق. ففي حالات تاريخية فوضوية كهذه تضيع المسؤولية إذ يلقي بها كل طرف على الآخر، ويكون لكل اتهاماته ودلائله، أما الجمهور فإنه يلقي بصوت العقل وراء ظهره ويلقي بالمحاكمة النقدية العقلانية في سلة المهملات وينسى الشك المنهجي نهائيا لصالح الاقتناع المسبق الغرائزي. بمعنى أن كل فرد يصدق من هو جاهز عاطفيا لتصديقه ويكذب من هو جاهز منطقيا لتكذيبه، وليذهب المنطق إلى الجحيم. وإذا كان خبراء الانتلجنسيا الأمريكية يعلقون هذه الأيام على أحداث مصر بالتأكيد على أنها ستطول، فإن ذلك يعني نشر الفوضى وتصعيدها وصولا إلى المزيد من الضجيج ومن الغبار، وإلى مزيد من الأحقاد والتحدي، وحتى الدماء، بحيث يصبح السؤال: إلى أين المآل؟ هل يمكن أن تصل الأمور يوما إلى تقسيم مصر، بعد تدمير طاقاتها؟
قد يبدو هذا السؤال مبالغا في التطير والتشكيك، ولكن ألم تقل لنا الصحافة الإسرائيلية غداة احتلال العراق: ” أما مصر فهديتنا الكبرى “؟ فهل جاء وقت توضيب الهدية الكبرى؟ خاصة أن التجربة قد علمتنا أن التقسيم في العالم العربي لا يفترض حكما الوصول إلى تقسيم رسمي، يعترف بكل جزئية دولة، بل إنه يتمثل في تقسيم واقعي على الأرض على أسس دينية، مذهبية، طائفية أو عرقية. لا يرتقي إلى مستوى الفصل القانوني لكنه يشل نهائيا قدرات الدولة كدولة ويعرضها للاقتتال والتدمير الذاتي باستمرار. بل والأخطر من ذلك أن هذه الأجزاء المشرذمة تصبح – في غياب سيادة الدولة – أقل من أن تؤمّن أمنها بذاتها، وتعيش حالة قلق من عدائها مع الأجزاء الأخرى، وبالتالي فإن الحل الذي تجده أمامها هو اللجوء إلى حماية أجنبية من هذا الطرف أو ذاك. وقد رأينا عشرات النماذج بدءا من لبنان وصولا إلى العراق.
وهنا لا بد من وضع الأمور في سياق مخطط عام بدا واضحا للمنطقة العربية منذ بداية التسعينيات، ألا وهو القضاء على الدول الماكرو، لصالح دول ميكرو، في إطار هدف واضح هو عدم الإبقاء على أية فرصة لحصول مفاجآت أو تطورات تعود بدولة عربية إلى ممارسة سيادتها وامتلاك قرارها. عودة تسبب صداعا للدول الكبرى التي تسيطر على العولمة ولا تريد من يحلم بحق السيادة ويمكن أن يضع مطالب وطنية مقابل أي دور جيوستراتيجي، أو حتى أي دور وظيفي، وكذلك تسبب عدم رضا لكل الدول التي تطمع بثروات العالم العربي ولا تريد دولا قادرة حتى على المساومة بخصوص هذه الثروات. ولذا فإنه لا بد لأي خبير انتلجنسيا في هذه الدول أن يطرح على نفسه السؤال: من يضمن ألا تصل البلاد يوما، إذا ما تمتعت يوما بحريات حقيقية وبدستور حديث وبحياة حزبية ديمقراطية، – ألا تصل إلى الحلم من جديد بالاستقلالية وبالأمن الاقتصادي والسياسي وبامتلاك القرار؟ وأن تعود بذلك إلى قيادة العالم العربي في الاتجاه نفسه؟ من هنا فإن الضمانة الوحيدة هي أن تكون مصر منهكة ممزقة مجزأة ولو نفسيا وواقعيا ولا تكاد تلملم ثوبها للنهوض حتى تتعثر به من جديد.