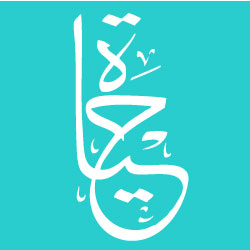هل سينقل السفارة الأميركية إلى القدس؟ هل سيفعّل دعمه للاستيطان؟ هل سيقف موقفاً عدائياً من المهاجرين؟ ومن المسلمين؟هي الأسئلة التي تضجّ بها وسائل الإعلام العربية في مواجهة الرئيس الأميركي الجديد، وكأنما الإجابات بحد ذاتها لا تشكّل إدانة عميقة للنظام الرسمي العربي، بل وللشعوب العربية، قبل أن تكونه لدونالد ترامب.ترامب ليس أول رئيس أميركي وعد خلال حملته الانتخابية بنقل السفارة، ولكنه قد يكون أول رئيس ينفّذ وعده لسببين بسيطين:
الأول أن السد العربي في وجه هذا الضغط الصهيوني، بات منهاراً. منهار بفعل الربيع العربي الذي لم تترك ناره أخضر ولا يابس، ومنهار بفعل التهالك العربي المتدحرج على رضى إسرائيل (أكثر مما هو لدى الأميركي) والوقاحة في كسر جميع المحرّمات الوطنية في هذا الاتجاه. والثاني أن العرب وضعوا في مجال العلاقات الدولية كل بيضهم في سلّة هيلاري كلينتون وكأن ترامب هو من احتل العراق وأسّس “داعش” ودمّر ليبيا وخفض أسعار النفط ودعم الأخوان المسلمين في صيغتهم الأكثر تشدّدا وعنفاً، بحيث فرّخت الجماعة العدد الأكبر من التنظيمات الإرهابية التي بتنا نخشاها في بيوتنا ودولنا.
ويبدو أننا – كما دائماً- قصيرو الذاكرة. فالمرشّح الجمهوري الذي بدا واضحاً، منذ بداية حملته أنه ليس جمهورياً بالمعنى التقليدي وإنما رأسمالياً قومياً حمائياً، لم يتخذ في بداية حملته موقفاً سلبياً من القضية الفلسطينية وإنما صرّح بأنه على أميركا، إن أرادت أن تلعب دور الوسيط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أن تقف على مسافة واحدة من الإثنين. بل أن زعيم حملته الانتخابية اتُهم بأنه أوصى زوجته بألا ترسل ابنها إلى مدرسة يهودية لأنها تعلّمه ما يتناقض مع المبادىء الأميركية. لكن المشهد تبدّل خلال الحملة فابنته إيفانكا التي تمسك بأعماله اعتنقت اليهودية الأرتوذوكسية لتتزوّج من رجل أعمال يهودي معروف، كوشنير (يذكرنا ببرنار كوشنير) مثلها مثل شيلسي ابنة هيلاري كلينتون. وإسرائيل تمد له من خلال لوبيهاتها العصا والجزرة والعرب لا يتقنون ذلك فعصاهم صراخ وشتائم وجزرتهم مجانية. أو تتمثل في الرشاوى التي تفقد فاعليتها عندما يشعر الطرف المقابل أنه قادر على انتزاعها من دون مقابل.
إذا حصل نقل السفارة سيكون نتيجة التخلّي العربي ولا نلومنّ إلاّ أنفسنا. وفي السياق نفسه يأتي دعمه للاستيطان. فقد كان مندوبو المستوطنات على مقاعد الضيوف في قاعة التنصيب، فيما كان العرب المعتدلون وغير المعتدلين كلهم في الخارج يصرخون ويدفعون ببضع مئات مع متظاهرين آخرين إلى الشوارع. وإلى متى؟ لأيام وأسابيع؟ وبعد؟في السؤال الثاني، غريب أمرنا، نحن منشغلون إزاء جميع حكومات العالم بموقفها من الهجرة، ولكننا لا نبدي أدنى اهتمام بوقف الهجرة. أي بموقف هذه الحكومات من الأسباب التي أدّت إلى الهجرة وفي مقدمها الاحتلال ثم الفقر، العنف، عدم الاستقرار، التخلّف والجهل، خاصة الجهل في النظرة إلى الجنة التي يمثلها الغرب وحلم الغرب. لم يكن الفلسطيني سيهاجر لولا الاحتلال، ولم يكن اللبناني ليهاجر لولا الاستعمار العثماني وسفر برلك ولم يكن ليهاجر من جديد لولا الحرب الأهلية وما ترتّب عنها من أوضاع اقتصادية وفساد. لم يكن السوري ليهاجر لولا ما يحصل في سوريا، ومثلهما المصري والسوداني والمغاربي. فهل رأينا يوماً سويدياً أو هولندياً يهاجر ويحلم بجنسية عربية؟ هذا كي لا نقول الدول الكبرى كأميركا وبريطانيا. حتى الفرنسي الذي يعيش أوضاعاً اقتصادية بالغة السوء يسعى لأن ينتزع من العرب مالاً بطريقة أو بأخرى كي يحسّن أوضاعه وإن كان الواقع أنه فشل في ذلك. بلادنا بلاد الزراعة والماء والبحر والمعادن والنفط والغاز، فلماذا نرتمي متسوّلين على أبواب بلدان لا ثروة لديها إلاّ عقولها؟ وأي حال كان حالنا لو أن ما أُنفق على التدمير أُنفق على التنمية؟ الاستراتيجية السياسية لعهد أوباما بلورتها ونفّذتها وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون، إلى جانب نائبه جو بايدن، قبل أن يأتي جون كيري ليحاول تدوير الزوايا والمراوغة بعد أن ثبت الوضع على الأرض أن الأمور لم تكن بهذه السهولة. وها نحن اليوم، وسائل إعلام وجمهور وطبقة سياسية نلطم ونشتم القدر الذي ذهب بهؤلاء من السلطة، حتى ليبدو وكأن كلينتون كانت أمنا الحنون التي حملت صدفة وولدت “داعش”.أما قضية الملف النووي الإيراني فقضية أخرى تدخل في لعبة المصالح وعضّ الأصابع التي يتقنها الطرفان بعقلية لا تمت للعقل العربي بصلة. ولذا نضعها هنا جانباً.لن يكون ترامب سيئاً ولا جيّداً، إلا بقدر ما نعرف كيف نتعامل معه.
الرجل ببساطة انقلاب على العولمة والإنفلاشية وعودة إلى الحمائية الرأسمالية، انقلاب سبقته إليه بريطانيا ولن تتأخر أوروبا عن اللحاق به، في انتخاباتها القادمة. واللوبيهات اليهودية تقوم بواجبها. وعلى العرب ألاّ يلحقوا دائماً بالركب متأخرين فتجرهم القاطرة وراءها بدلاً من أن تحجز لهم مقعداً فيها.