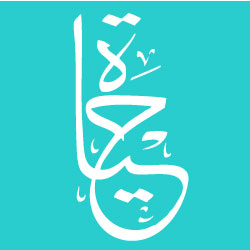هل بدا الأمريكيون يخشون من إفلات القوة المصرية، الكبرى في المنطقة العربية، من سلطتهم المطلقة؟ من تغيير القاعدة التي أطلقها أنور السادات، ومن ثم كرسها حسني مبارك وهي: كل الأوراق في يد الولايات المتحدة؟
كان ذلك ضمن السياق الدولي، حيث بدا الاتحاد السوفييتي انحداره إلى الهاوية ومن ثم وصلها متفككاً، تاركاً العالم للإمبراطورية الوحيدة.
اليوم يعود العالم إلى الصعود باتجاه التوازن المتعدد الأقطاب، الذي لا يعني أبداً خروج الولايات المتحدة من المشهد، وإنما رضوخها للشراكة. فهل يستشرف زعماء مصر الجديدة التحول الدولي القادم سريعاً، ويبنون على أساسه، كما بنى السادات على أساس استشراف العولمة الأمريكية، ونشوء مقابل لها هو العولمة الإسلامية؟ المنظرون الاستراتيجيون الغربيون أطلقوا على ذلك اسم “الكتلة المقابلة” والأمريكيون حاولوا – في عهد أوباما – أن يجعلوا من هذه الكتلة حليفة ولو من وراء حجاب، لاستبعاد الكتل الأخرى الصاعدة وفي مقدمتها روسيا والصين. لكن الخيار قد فشل، ويبدو أن استراتيجيي واشنطن كانوا يضعون خياراً تالياً هو جعل الفشل الإسلامي معولاً يمهد الطريق لليبراليين المتأمركين كلياً، وفي حالة بديلة لإقامة تحالف بين الحليف الإسلامي والحليف الليبرالي.
غير أن ثمة توجهات أخرى بدأت تتحول إلى مخاوف، من تطلّع العسكريين المصريين إلى ما لاقاه الجيش السوري من دعم روسي، وبعودة تاريخية إلى ما نعم به عبدالناصر يوماً من دعم سوفييتي ومن استفادة سياسية من التوازن الدولي.
واقعياً، لا يبدو هذا الخيار ممكنا في ظل ارتباط الجيش المصري ارتباطاً عضوياً كاملاً بالقوة العسكرية الأمريكية، تجهيزاً وتدريباً واستخباراتياً ومساعدات. ولكنه لا يبدو مستبعداً بشكل تدريجي. خاصة إذا ما أخذنا في الحسبان مقارنة الاستعلاء الذي تمارسه الولايات المتحدة إزاء مصر لقاء المساعدة في مقابل التعامل الروسي الندّي الذي جربته مصر أيام عبدالناصر.
وإذا كانت نظرة تاريخية تقول إن عبدالناصر جاء ضمن سياقه التاريخي المرحلي، حيث جاءت نهاية الاستعمار القديم، الفرنسي البريطاني، ليحل محلهما النفوذ الأمريكي والسوفييتي، وإن السادات جاء أيضاً ضمن سياقه التاريخي المرحلي، أي سيادة الهيمنة الأمريكية، فإنه لا بد من الاعتراف بأن نتيجة الإرادتين والسياقين أن الأول رفع مصر إلى حجم دول عدم الانحياز التي تقاوم التبعية وتطرح نفسها بيضة قبان، في حين ألحقها الثاني بذيل التنورة الأمريكية – “الإسرائيلية”. فكانت مصر بالخيار الأول قائدة العالم العربي وأصبحت نتيجة الثاني معزولة عنه وملحقة بمن لا يرتقون إلى حجمها ووزنها، إلحاقاً تدحرج وتفاقم تدريجياً من سيئ إلى أسوأ، وأفقدها دورها الطبيعي.
لذلك يبدو التهديد الأمريكي بوقف المساعدات، والاقتراح بتقسيط المساعدة الأمريكية السنوية للجيش المصري على أربع دفعات، كأنه نوع من الامتحان، وإعادة تقدير الموقف الذي ستخضع له مصر كل ثلاثة أشهر.
لكن ألا يبدو هذا سيفاً ذا حدّين،قد يجبر المصريين على الالتزام أكثر بالاقتراحات الأمريكية والغربية لحل الوضع المصري، وقد يحفزّهم أكثر على البحث عن بدائل؟
هل إن تدارك هذا الاحتمال هو ما يحفّز أوروبا إلى السعي عن إتمام المصالحة بين الحكم الحالي والإخوان المسلمين لتكتمل سياسة العصا والجزرة؟
هل سيقبل الحكم الحالي بهذه المصالحة، خاصة بعد لجوء الإخوان بدورهم إلى سلوك طريقين متوازيين: الاستمرار بالتهديد بالعنف، من جهة، وتسويق وجوه جديدة غير التي انصبت عليها الاعتراضات الشعبية خلال حكم مرسي – وذاك ما قرروه في مؤتمرهم الدولي في اسطنبول الشهر الماضي، في حين تذهب الوجوه القديمة ضحية تغيير القناع؟ وهل ستتم هذه المصالحة على حساب القوميين والديمقراطيين الحقيقيين، ولإبعادهم، أم أنها ستهدد بضرب صدقية الحكم الجديد، أم أن خرائط سياسية جديدة سترتسم على الساحة المصرية وفق تشكيلات جديدة بعضها كان قائماً تاريخياً وبعضها الآخر ولد من رحم الثورة؟