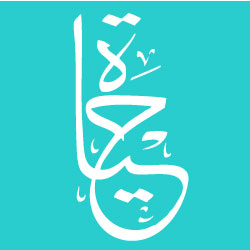رحل الكبير من دون كبار. مضى العملاق منذراً بانقراض العمالقة من ساحة الفن الطربي العربي، ومتخطياً الإنذار إلى التأكيد على انقراض العمالقة من ساحة السياسة اللبنانية. فلم يتحقق له مأتم وطني كما يليق بحجم عطائه ضمن الوجود اللبناني والعربي.
مصادفة كنت في الجزائر يوم توفيت وردة. علّق التلفزيون الجزائري برامجه لمدة ثلاثة أيام، باستثناء نشرات الأخبار، ليبث باستمرار برامج عن الراحلة الكبيرة: حياتها، أعمالها، أسرتها، شهادات لمن عملوا معها. أما التركيز فكان على أمرين: الأول الدور الوطني للفنانة الكبيرة، منذ طفولتها وعملها في ظل أخيها المناضل في الجهاز الخارجي للثورة الجزائرية، إلى حرصها التام على إحياء أعياد الاستقلال حتى آخر حياتها. أما الأمر الثاني فهو القيمة الفنية الأصيلة التي مثلتها الفنانة في إطار الثقافة العربية والجزائرية.
أمّا المأتم فقد بدأ مع وصول الجثمان إلى المطار على متن طائرة رئاسية أرسلت لتحمله من القاهرة، حيث حملته ثلة من ضباط الجيش الجزائري على الأكتاف إلى المركز الثقافي في وسط العاصمة الجزائر، حيث تلقته النسوة بالآلاف من الزغاريد على الطريقة المحلية، ومن ثم سجّي في قاعة المركز كي يلقي عليه المواطنون النظرة الأخيرة لمدة 24 ساعة، قبل أن يدفن بمراسم رسمية.
كواحدة من آلاف العاملين في الثقافة والفنون في العالم العربي، أحسست يومها أنني أنتمي إلى بلاد حضارية تعرف كيف تثمن وتنمي قيمها ومساهمتها، وأحسست بالامتنان والاحترام للجزائر. وبهذه الصفة أيضاً أحسست بالغصة والإحباط، وبالنقمة المرّة على دولة لبنانية لا تثير فيّ الامتنان ولا الاحترام.
كواحدة من مئات ملايين العرب العاديين، أحسست أن إنساناً يمنحني هذه المتعة الراقية المحترمة ويحفظ وينمّي لي كل ما هو جميل وأصيل في تراثي، بل ويبدعه بإضافة جديدة، هو إنسان يمثلني، ولذا فإن احترام الدولة له هو احترام لي. والنقيض هو ما أحسسته في وداع الصافي.
كلبنانية من جيل عاش الستينات وما بعدها، لم أتمالك نفسي من مقارنة: ماذا لو مات واحد من أمراء الحرب الأهلية اللبنانية الذين صعدوا إلى عروشهم المادية والسلطوية على جماجم العباد وركام البلاد؟ أو واحد من الذين أعطوا للبنان موقعاً على خريطة فوربس لأغنى أغنياء العالم أو أغنى أغنياء العالم العربي، في حين يبحث بعض اللبنانيين عن اللقمة في حاويات القمامة؟
لهؤلاء ستقام جنازات رسمية وشعبية، وتهرق أطنان الورود ويصطف الجيش لتحيتهم، الجيش الذي يفقد شبابه كي يظل لبنان “أخضر حلو” كما رآه الصافي.
أجل وديع الصافي جعلنا نرى لبنان أحلى مما هو، ورفعه إلى “قطعة سما” وهتف بمصر “عظيمة يا مصر”، فظل الهتاف يتعتق عقوداً واعتنقه ثوّار ميدان التحرير فأنشدوه. وديع الصافي هو من جعل عبدالوهاب ينسى البروتوكول في حضرة عبدالناصر ويقف هاتفاً لزميله : الله يا وديع!!
ثلاثة أسماء كبيرة، أين لنا بمثلها كل في مجاله؟ غيابها هو رمزية غياب الكبرياء الوطنية والحضارية عن ساحاتنا التي طغت عليها قمامات الاستهلاك وقيمه المنحطة.
وديع الصافي هو الذي كرّس جل عمله الإبداعي نداء للمهاجرين كي يعودوا: “يا غايبين، انتو أحلى الحبايب” وسياسيو لبنان هم الذين كرّسوا صراعات الديكة، ووحول الفساد والخراب وسيلة لدفع كل من تبقى من الشباب إلى الهجرة.
وديع هو الذي عرف كيف يظل كبيراً في أدائه وفي حياته، وكيف يظل بسيطاً بساطة من لا يحتاج كبرياؤه إلى ادّعاء ولا تحتاج قيمته إلى شهادة. كل ما يحتاجه هو تلك البسمة العريضة العظيمة العفوية التي لا تشبهها إلا الشمس على جبال نيحا، حيث ولد أو جبل صنين، حيث غنى لهما معاً.
قصّروا في حق وديع الصافي. وبالأمس منصور الرحباني ولا ندري في حق من سيقصّرون غداً.
لكنهم في الواقع لم يفعلوا إلا ما يناسب قياس فهمهم للثقافة والفنون ودورهما في ارتقاء الشعوب، وشد لحمة الأمم وصيانة وإبداع خصوصياتها وخطها الفكري الذي يجعل منها شعباً لا قطيعاً.