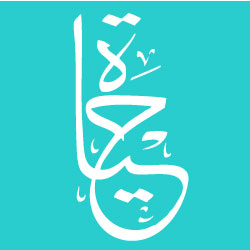بعض المفكرين يظلمون اذ يتحولون الى زعماء سياسيين، حتى وان لم يريدوا ذلك بالمعنى التقليدي.
وبعضهم يظل كرمز اكبر من كل رجال الدول والمسؤولين الذين تفرش لهم السجادة الحمراء.
فهل استطاع واحد من الذين حكموا باسم الماركسية ان يصل لان يكون ماركس؟ وهل استطاع واحد منهم ان يصل لان يظل رمزا حيا يستشهد به حتى اشد خصوم الماركسية كما كان تشي غيفارا، الذي سمعنا اكثر من مرة التعبير عن وجوده كمرجع في ذهن مرجعيات دينية نضالية كحسن نصرالله وهاني فحص الذي يعترف بانه يضع في بيته في قم صورة كبيرة لجيفارا؟
ولكن.. عندما تجتمع في رجل صفتا المنظر المؤسس كالاول والمناضل حتى الشهادة كالثاني وفي امة تعيش ارهاصات التطلع الى مستقبل الحرية والكرامة، فان ظلما كبيرا يقع عليه عندما يقتصر الاحتفال به على اتباعه ورفاقه.
والاحتفال هنا ذو وجهين: وجه المعنى الفعلي كالاحتفال بذكرى استشهاد ووجه رمزي بما تعنيه الدراسة المعمقة الموسعة لفكره واعماله في سياق العلوم التي ينتمي اليها نتاجه.
من هنا جاءت الندوة الصغيرة التي اقامها منتدى ابن رشد بمناسبة ذكرى استشهاد انطون سعادة عام 1949 لتحمل دلالة خاصة: اولها انها لم تقتصر، كما عودتنا الاحتفالات الحزبية على المنتمين الى الحركة القومية الاجتماعية، حاليا او سابقا، سواء في الحضور ام في المتحدثين، وثانيها انها حاولت تسليط الضوء على الرجل مفكرا ومناضلا، مما يعطي مشروعية حقيقية لطرحها.
فالرائد القومي النهضوي الذي تآمرت عليه افرازات سايكس بيكو مع افرازات بلفور مع موروثات قرون الانحطاط، ويهود الداخل الذين اعتبرهم هو اخطر من يهود الخارج، لم يكن اول الشهداء ولا اخرهم، كما لم يكن اول ضحايا المؤامرة الكبرى التي تستهدف الوطن كله والامة وجودا.
كما انه لم يكن المنظر الايديولوجي الوحيد في مكان وزمان لم يشكلا الا مرجلا يغلي بمحاولات ادلجة التوق الوطني العفوي والطبيعي لامة يجهض ليلها العثماني ثم الانتدابي، ويكتنز رحمها تنامي نطفة الاستقلال والتحرر وتحديد الهوية.
ولم يكن الزعيم الوحيد في بلاد تشظت الى بلدان وتشطت زعاماتها الي نتف ليس بعدد الايديولوجيات فقط وانما بعدد الطوائف والاعراق والمناطق.
اذن فأين تكمن الفرادة التي تجعل الرجل مستحقا لتكرار الاحتفال؟
الفراده هي فعليا في نقطتين جوهريتين المشروع النظري واقترانه بالتطبيق العملي حتى الاستشهاد.
ففي المشروع جاء انطون سعاده بالرؤية القومية الاجتماعية التي اسست مفهوم الامة على الخط الفكري المحدد للخصوصية، والناتج عن التفاعل التاريخي الممتد بين بيئة جغرافية معينة والجماعة البشرية التي تعيش وتتفاعل عليها ومعها، مما يلغي تاليا اية انتماءات عرقية او دينية او طائفية، ويحول التعددية الى مصادر قوى تلتئم فيما بينها لتشكل قوة واحدة متينة ومتراصة في مواجهة الاخر، صديقا او حليفا او عدوا، بدلا من ان يجعلها التفسخ الانتمائي قوى يستنزف واحدها الاخر في عملية تدمير ذاتي منهكة.
وفي البعد الفلسفي، كانت المدرحية هي تلك النظرة التي الفت التضاد المفتعل بين المادة والروح، بين النظريات المادية وتلك النيزفانية التي تلتفت كل منها الى نصف الكائن وتنكر نصفه الاخر، مقيمة سلاما في الرؤية كما في الحياة.
كذلك نظم فكر سعاده العلاقة بين الفرد والمجتمع على اساس الانسجام بين الجزء والكل، انسجاما يقوم على الدوائر المتلاحقة، ضامة كل منها الاخرى ضمن النقطة – البؤرة: الفرد الى المتحد الاجتماعي الاول: الاسرة، ومنه تتلاحق الدوائر حتى المجتمع – الانسان مما تصدر عنه رؤى متناغمة تنظم منظومة القيم وتفسرها.
واذا كانت الترجمة السياسية هي السعي لتحقيق وحدة الامة واستقلالها التام، فانما يرتبط ذلك ارتباطا وثيقا بالاسس التي تشكل نظامها الحياتي والفكري لمحات سريعة مبسطة لفكر كبير لم يأخذ حقه في الدراسات الاكاديمية وساحات الجدل الفكري، حيث تركزت المحاكمة دائما على الشق السياسي وحده. ليظل ان ما يعطي هذا المفكر الكبير فراده نضالية هو الطريقة التي عاش بها حياته، والبنية المسلكية النظامية التي اسس عليها حزبه الذي كان يصر على تسميته بالحركة، لانه اعتبره الحركة المنظمة الواعية للامة.
بنود كثيرة ما تزال بحاجة الى الكثير من الدرس والنقاش، خاصة مع مرحلة تداعي الافلاسات والكوارث.