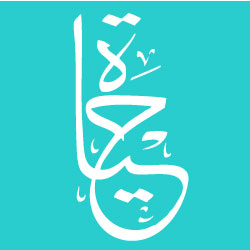في الفلسفات الشرقية أن المعرفة الحقيقية هي الكشف، لا المكتسب، بمعنى أن كل ما نكتسبه من معارف وعلوم من سلوكيات، بل ومما يبدو حقائق هو أشياء خارجية، خارجة عن الذات، ملقنة بطريق مباشر او غير مباشرة. ولذلك فإن المعرفة الحقيقية هي تلك الكامنة في أعماق نفوسنا، المتصلة بالمعرفة الكلية، والتي يمكنها الكشف عن كل شيء إذا ما كشفت عنها حجب المكتسب الجاهز.
وإذا كان اكثر هذه الفلسفات يمضي الى أبعاد روحانية تجعل من حالة الكشف هذه، تجلياً مرتبطاً بتجاوز العقل الى الروح، فإلى الاشراق.
فيما عبرت عنه القصة الرمزية التالية:
ان رجلاً كان يجلس على حافة البحيرة، متأملاً، محاولاً أن يصل الى حالة الكشف، فجاءه راهب (زن) وفي يده قطعة فخار، وسأله: هل تعتقد أنه يمكن لهذه القطعة ان تتحول الى مرآة مهما صقلناها؟
وعندما اجابه بالنفي، قام الراهب برمي القطعة في البحيرة، مما أصدر صوتاً صغيراً، ثم شكلت دوائر متتالية لم تلبث ان اختفت، لتعود البحيرة الى صفاء صفحتها، وهدوئها.
فقال:
الآن اصغ الى الصمت، وانظر الى مرآة البحيرة.
هكذا أنت كإنسان، لا يمكنك أن تكشف مرآة روحك إلاّ إذا رميت العقل المكتسب في البحر، واصغيت الى الصمت.
فانني لا أريد هنا الدخول في عمق الفلسفات الشرقية، خاصة فلسفة الزن، المعتمدة على “الطبيعة المبدعة” رغم ما في هذا الدخول من متعة ابحار في مجاهل بلورية، او في غابات بكر سحرية.
وانما اقصد أن انقل الى حيز التبسيط والتطبيق اسئلة عملية تتعلق بتعاملنا بعضنا مع بعض، بدءاً من حياتنا الثقافية والتعليمية، الى حياتنا اليومية العادية.
الى أي مدى يمارس كل منا عملية الاصغاء الى الصمت: صمت الطبيعة وصمت الذات؟
وفي غياب حالة الاصغاء والتأمل هذه، يصبح الحس الحقيقي بالكلمة، لا بكونها لفظاً، وانما بكونها معنىً، حساً شبه مفقود، فيتفضفض الكلام على مضمونه ويترهل، بل ويغيب عنه في حالة انفصام مرضية.. وببغائية ميتة. ليتكرر ويتشابه، مع موت تدريجي للطبيعة المبدعة، يصل بالجميع الى التيه في حشد مومياءات محنطة.
الى أي مدى يمارس كل منا عملية الاصغاء الى الآخر، سواء كان هذا الاصغاء، اصغاء الى كلامه أم اصغاء الى صمته؟
هنا أيضاً ليس الجواب أبداً في صالح التواصل الانساني، بل أنه يقع في خانة: “تكسرت النصال على النصال” ليغيب بالتالي ايضاً أي حوارٍ بين عناصر الطبيعة الانسانية الكامنة في اثنين او اكثر، ويغيب معه التقبل والقبول، او ما هو أعمق: التناغم الذي لا يعني أبداً التشابه. وتتخزن العدوانية المدمرة.
السؤال الثالث، وليس الأخير، إذ لا نهاية للأسئلة المنبثقة من هذا الطرح هو:
الى أي مدى يحق لنا نحن أن نقارب سمو “الكشف” وتجليات “الطبيعة المبدعة” ونحن نتبارى في التلقين البليد المستغبي:
اعلام يستغبي المتلقي، ويحشو حلقه بكتل عجينية جاهزة للبلع بدون مضغ.
وقبل ذلك: هو الاعلام الذي يتلقى أيضاً بغباء، كل ما تسوقه مصادر الأنباء العالمية، التي لا تبث صورة (بل لا تلتقطها) ولا نبأ ولا كلمة واحدة، إلا كنغم مدروس بدقة في سمفونية مخططة لأحداث تأثيرات سيكولوجية محددة بدقة لدى الرأي العام، لتحويله في اتجاهات استراتيجية، غالباً ما تكون ضد مصالحنا.
وفن، ناقل ناسخ، مقلد، يستغبي مؤديه، ومتلقيه، ويفتقر في كل حالاته الى الابداعية المبتكرة، الى الكشف، الى الطبيعة المبدعة..
ومناهج ومدرسون يستغبون الطالب، طفلاً وكبيراً، فيلفون انسانيته، ليحولوه الى شريط تسجيل، غير مضطر للاصغاء اذ تكفيه ميكانيكية التسجيل.. أما طبيعته المبدعة فجريمة يعاقب عليها قانون الامتثال، والتشابه والتقليد القردي و…و…
كل ما يجعلك كل شيء إلاّ “أنت” .