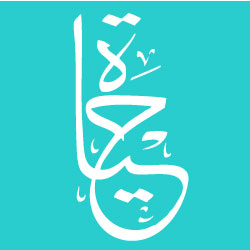لم يُشكّل انتخاب دونالد ترامب منعطفاً تاريخياً في مسيرة التاريخ السياسي، بل أيضاً في تاريخ الميديا التي عجزت عن تحديد مصير الانتخابات أو حتى توقّعه. المُلاحظة الأهم التي يُمكن أن نخرج بها من هذه المحطّة هي أن الدعاية السياسية الانتخابية هذه قد عنت بمعالجة أزمة داخلية، اقتصادية- اجتماعية ( وإن تكن ذات بُعد عالمي)، كما عنت بابتكار تقنيات لحشد الرأي العام حول برنامج جديد للخروج منها.
عَبر التاريخ ارتبط تطوّر وسائل الاتذصال الجماهيري بأمرين: الحروب والانتخابات. هذه المقولة مُسلّمة تُدرّس في كل كليّات الإعلام في العالم. وإذا كان الدخول في تفاصيل هذه المقولة يعني قراءة تاريخ هذا التطوّر، خطاباً ووسائل وتقنيات عبر أكثر من قرن فإن ما يستحق إثارة الموضوع اليوم هو أن الانتخابات الأميركية الأخيرة شكّلت مفصلاً تاريخياً جديداً في هذا التطوّر.ثلاثة مفاصِل في تاريخ علاقة الإعلام بالانتخابات الأميركية: الميديا ساهمت في نجاح فرانكلين روزفلت للولاية الأولى عام 1936، وسجّلت تطوّراً هائلاً في تاريخها العلمي قبل وخلال ولايته الثانية 1936، المُناظرة التلفزيونية صنعت نجاح جون كنيدي عام 1960عندما قلبت الميزان بينه وبين نيكسون، وفي عام 2016 فشلت الميديا في إنجاح هيلاري كلينتون رغم اصطفافها إلى جانبها.من هنا لم يُشكّل انتخاب دونالد ترامب منعطفاً تاريخياً في مسيرة التاريخ السياسي، بل أيضاً في تاريخ الميديا التي عجزت عن تحديد مصير الانتخابات أو حتى توقّعه. بالعودة إلى المحطّات السابقة نجد أن الدعاية السياسية في انتخابات روزفلت الأولى تمحورت حول مفهوم ” العَقد الجديد” (new deal).وتقنيات تشكيل الراي العام وحشده حول برنامج welfare state للخروج من الأزمة التي كانت تعيشها البلاد والعالم منذ عام 1927، ومن رحم هذا الجهد البحثي المُرتبط ارتباطاً وثيقاً بالواقع الداخلي قبل الخارجي، نشأت التطوّرات الكُبرى في مجال الميديا من ظهور مؤسسات استطلاع الرأي : غالوب، روبر وغروسلي التي نجحت في توقّع فوز روزفلت للولاية الثانية عام 1936، إلى ظهور أول مجلّة علمية مُتخصّصة بدراسات الاتصال الجماهيري والرأي العام، في العام التالي (1937)The public opinion quarterly أصدرتها الجمعية الأميركية لأبحاث الرأي العام AAPOR.المُلاحظة الأهم التي يُمكن أن نخرج بها من هذه المحطّة هي أن الدعاية السياسية الانتخابية هذه قد عنت بمعالجة أزمة داخلية، اقتصادية- اجتماعية ( وإن تكن ذات بُعد عالمي)، كما عنت بابتكار تقنيات لحشد الرأي العام حول برنامج جديد للخروج منها. وعليه نجحت مؤسسات استطلاع الرأي في توقّعاتها، على عكس ما حصل في الانتخابات الأخيرة. ومن هنا السؤال: لماذا ابتعدت الميديا هذه المرة عن الرأي العام حشداً وتوقعاً؟ النقص في تقنياتها؟ أم لنقصٍ في قربها من الرأي العام، الدولة العميقة ؟أم لنقص في استشعارها لرياح التّوق إلى التغيير؟ أم لنقص في حياديّتها وارتهانها للوبيهات ومراكز قوى مُحدّدة كانت تقف إلى جانب كلينتون؟. أسئلة تقود إلى سؤال آخر يتعلّق بانتخابات كنيدي: لماذا لم تؤثّر على النتائج المُناظرات التي بدت وكأنها تُسجّل تفوّقاً لكلينتون؟ أم أن هذا التفوّق هو ما رأته الميديا المدينية المذكورة لا ما رآه الرأي العام الأميركي والمندوبون الناخبون؟ وهو ما رأيناه نحن بعين مقاييسنا التي انطلقت من أمرين: صدى ببّغائي للميديا الأميركية ( التي ندّعي مُعاداتها ونتقمّصها وجدانياً) وردّات فعل عاطفية لا تقرأ الواقع بل المخاوف والتمنّيات؟.”أنتم مستيقظون… أنتم لا تحلمون حلماً شنيعاً، لستم أمواتاً ولن تذهبوا إلى الجحيم… هذه حياتكم الآن… هذه انتخاباتنا وهذه بلدنا… هذه هي الحقيقة”كانت تصرخ مذيعة أم أس أن بي سي، راشيل مادو وهي تُعلن النتائج.الحقيقة! أجل هي ما كتبته مارغريت سولليفان في الواشنطن بوست ” بصراحة، لقد تخلّفت الميديا عن موعدها مع التاريخ “أو كتبته كاتلين باركر متجاوزة الاعتراف إلى الأثر:”الإعلام الأميركي هو الخاسر الأكبر في انتخابات 2016 وهذا يُمكن أن يُلحِق ضرراً بالأمّة أكثر مما يفعله العدو الخارجي”.لذا انكب الباحثون والصحافيون على البحث عن السبب فور ظهور النتائج. لتأتي الحقيقة صادمة في وجوه عدّة:أولها علاقة الميديا بالرأي العام حيث دلّت الدراسات الأولية على أن 18% فقط من الأميركيين يثقون بالأخبار المحلية، 22% يثقون بحيادية الأخبار الوطنية ،4% ثقتهم بوسائل التواصل الاجتماعي، لذلك كان هجوم ترامب المُتكرِر على وسائل الإعلام صدى لما يراه الناخبون، بل أن كاتب أخبار وهمية يُدعى بول هيرنر قد اعترف بأن ما كتبه لتشويه صورة ترامب جعل الناخبين يصوّتون له.ثانيها علاقة الميديا بالتكنولوجيا حيث كتب جيم روتنبرغ في نيويورك تايمز: “لم تستطع التكنولوجيا المُتطوّرة والقراءة الحديثة لقواعد البيانات أن تُنقذ الصحافة الأميركية من أن تبدو مُتخلّفة عن التاريخ وعن بقية البلاد”. ما يُعيد إلى الساحة الصراع العلمي بين أصحاب نظرية الحتمية التقنية وأصحاب نظرية الحتمية الاجتماعية، ويمنح تفوقاً تجريبياً واقعياً للثانية، في مجتمع يقوم نهجه العلمي على التجريبية.أما ثالثها فهو الموقف من استطلاعات الرأي وهو أيضاً قضية علمية مُثارة بقوة منذ سنوات على الساحة العلمية الغربية حيث كانت ثُلّة من العلماء والباحثين تُشكّك في مصداقية وجدوى الاستطلاعات وعيّناتها في حين كان الباحثون الأميركيون يؤيّدونها أو كما تقول صحيفة يو أس تو دي: ” كانت أوساط الميديا الأميركية تمنح ثقة عمياء لمؤسسات استطلاع الرأي”.لتعود فتتساءل: ” كيف أمكن لاستطلاعات الرأي أن تُخطىء إلى هذا الحد ؟”وتلاقيها الواشنطن بوست بالملاحظة: “حتى ولو كان الجميع يعرف أن نتائج الاستطلاعات ليست نتائج التصويت”، لتأتي نيويورك تايمز وتُقدّم الرّد المُر: “كانت عيون الصحفيين مُنكبّة على استطلاعات الرأي ما منعها أن ترى الخارج… لم تكن الأرقام فقط دليلاً سيّئاً وإنما كانت أيضاً تبعدنا عن الواقع”.الواقع! كان قد أشار إليه أكثر من باحث ولكن الميديا لم تأخذه بعين الاعتبار، فعلى سبيل المِثال كانت لور ماندفيل، مديرة مكتب أميركا في صحيفة لو فيغارو قد أصدرت قبل شهر من انتهاء الحملة الانتخابية كتاباً بعنوان:”مَن هو دونالد ترامب”؟ وعندما سُئلت عن إمكانية نجاحه قالت:”أنا لا أثق بنتائج استطلاعات الرأي… حقيقة المعركة هي بين الستاتوكو – السدّ، الذي تُمثّله كلينتون، وعليه يُدافع عنها كل رموزه بشراسة، وبين التجديد – الموجة، الذي يُمثّله دونالد ترامب… كل المسألة هي: هل ستكون موجة الغضب كافية للانتصار على السدّ ؟”.وفي هذا التقت ماندفيل مع بيغي نيومن في وول ستريت جورنال: “الجواب يكمن في نسبة القوة بين شعورين، الغضب والخوف: الغضب الذي يشعر به البلد إزاء النظام وإزاء النُخب والخوف من المجهول الذي يُمثّله دونالد ترامب”.لماذا لم تنتبه الميديا الأميركية إلى هذا الغضب؟ لماذا لم تكتب عنه إلا بعد حصول الصدمة؟. سؤال يتجاوز مصداقية وقيمة استطلاعات الرأي إلى مراجعة دور الميديا بكليّته، وعلاقتها بالناس، بالرأي العام. وذلك ما اعترفت به متأخرة، مارغريت سولليفان في واشنطن بوست: “الأمر أبعد من فشل الاستطلاعات، إنه فشل الميديا في التقاط غضب جزء كبير من الناخبين الأميركيين الذين يشعرون بأنهم متروكون ومهملون… كان الناس يريدون التغيير شيئاً جديداً مُختلفاً عن الطبقة السياسية التقليدية، صرخوا ورفعوا الصوت لكن الميديا لم تسمعهم… ذهبنا إلى ولايات جمهورية، التقينا بعاطلين عن العمل بسبب فقدان عملهم في صناعة السيارات، وبعمال قاصرين… لكننا لم نأخذ ما قالوه على محمل الجد”.هذا الافتراق بين الميديا وصناديق الاقتراع يشهد على انقسام عميق بين الميديا والمجتمع، بين شريحة مدينية تعيش على الشاطىء الغربي وفي المدن الكبرى كنيويورك وواشنطن وبين شريحة أخرى تُمثّل أميركا العميقة. وهذا ما يعترف به بول غروغمان الحائز جائزة نوبل للاقتصاد عام 2008، إذ يعترف بتجاهل، بل بجهل أميركا النُخب لأميركا العميقة”.”معظم قرّاء نيويورك تايمز لا يعرفون البلد الذي نعيش فيه… معظم الذين يعيشون في المناطق الزراعية لا يشاركوننا رؤيتنا لأميركا”.لذلك فإن هجوم ترامب على الإعلام الذي كان يعدّه المتابعون جنوناً، كان يشكّل صدى لنفوس الكثيرين، بل إن فهم خطابه كان مختلفاً تماماً بين الميديا والجمهور: “كنا نأخذ ما يقوله حرفياً ولكننا لم نكن نأخذه على محمل الجد، بينما كان الجمهور يفعل العكس تماماً” تعترف واشنطن بوست.هذا الاعتراف سيُعيد خلط الأوراق في علوم الاتصال الجماهيري، حيث سيعود تيّار الدراسات الثقافية إلى الواجهة بقوة، وهو التيّار الذي رفع شعار : “لا تسألوا ماذا تفعل الميديا بالمُتلقّي بل اسألوا ماذا يفعل المُتلقّي بالميديا”. ستعود مسألة تركيب الشيفرة وتفكيكها (Encoding- Decoding). إلى النقاش من جديد، نقاش سيتركّز بقوة على استجابة الميديا لهموم وقلق وتطلّعات الجمهور ، على المصداقية التي يتعامل معه بها، على عدم التعامل مع الجمهور كحشود عمياء يكفي اتقان عملية التلاعب وتركيب ( البراند) لكي نكسبها.عام 1990 كتب بريجنسكي: “بعد عصر المال وعصر المدفعية أصبحت وسائل الاتصال وسيلتنا الأولى للهيمنة على العالم”، والآن يرتسم السؤال: ربما تكون قد نجحت في الهيمنة على العالم، ولكن هل فشلت في الهيمنة على الداخل؟.أسئلة قد تُزلزل الدراسات الإعلامية في الغرب وتصل به إلى تطوّرات علمية كبرى في مجالات الاتصال الجماهيري. لكنها أيضاً تطرح بحدّة أمام إعلامنا في هذه المنطقة التي تتميّز عن الساحة الأميركية بثلاثة أمور: الأول أن جمهورنا لا يقصر اهتمامه على الساحة المحلية، بل يولي اهتماماً – ربما أكبر- للساحة الدولية لأنه يعرف ببساطة أن مصيره يتقرّر عليها.والثاني أن الفجوة بينه وبين الجمهور ليست بحداثة مثيلتها الأميركية، وإنما أقدم وأشدّ.أما الثالث، فهو وللأسف النقص الهائل بل وشبه الانعدام في الدراسات العلمية في مجال الميديا. فمعظم ما في المكتبات استنساخ تجميعي لدراسات غربية لا يتم تطبيقها علمياً على الواقع المحلّي –مع أخذ الخصوصية بعين الاعتبار- بجرأة تخرج بقراءات نقدية وتخطيط واعٍ. أو دراسات كميّة تجمع استطلاعات وتُلقّمها للآلة ( الأكس أل) وها هم أصحاب الآلة يعترفون بعجزها.