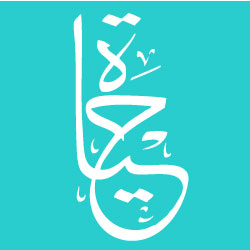توظّف وسائل الاتصال الجماهيري بشكل مُبتذل لم يسبق أن شهدته معركة رئاسية، فكأننا أمام مسرح تراجيكوميدي، ولكنه ليس أبداً مسرحاً أبلهاً كما يتخيّل البعض. هو صوغ إعلامي يتبنّى نظرية لاسويل بشأن الدعاية ولكنها من جهة أخرى لا تغفل كل المدارس الأخرى التي تقوم على دراسة الجمهور وتدريب قادة الرأي واستخدام الرموز المؤثّرة، التي بلغت حد إنتاج فيلم يلتقي فيه ترامب مع السيّد المسيح ويُدين الأخير المُرشّح الجمهوري.
أياً يكن الرئيس الذي سيصل إلى البيت الابيض في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، فإن المعركة الانتخابية الأميركية قد كشفت النقاب عن وقائع وتحوّلات سوسيولوجية هامة في بُنية الدولة العُظمى التي استطاعت أن تكون آخر امبراطوريات التاريخ الحديث، وستظل القطب الأكبر في عالم تعدّدية الأقطاب الآخذ في التبلور. تحوّلات، بمعنى التطوّر وليس بمعنى الجِدّة، ذاك أن القضايا التي تبرز أمام المراقب المُحلّل تُعيد إلى بداية التشكّل الاجتماعي والنظري للولايات المتحدة.في النقطة الأولى، تقوم كل دولة في العالم على أيديولوجية مُعيّنة، والولايات المتحدة قامت – وما تزال تقوم – على أيديولوجية المنفعة التي كانت كل ما ربط “جماعات من المهاجرين”، على حد تعبير توكفيل. هذه الأيديولوجية تعني أمرين أساسيين: الحفاظ على التفوّق والاستقرار الاقتصاديين، والحفاظ على التفوّق السياسي، وفي التطبيق العملي كلاهما يعتمدان على التفوّق العسكري. إلا أن عنصر القوة هذا قد شكّل في رأي الكثيرين من مُنظّري السياسة الأميركية عنصر ضعف، كما حلّل بول كنيدي في كتابه الشهير : “صعود وسقوط الامبراطورية”. لأن ضرورات التفوّق ومساحة الانتشار الجغرافي غير المعقول للجيش الأميركي، تؤدّي إلى تراجع الوضع الاقتصادي في ما يمكن أن يُشكّل أزمة وجودية مُدمّرة.
الحل عند البعض يكمن في ما يُسمّى الانعزالية الحمائية وراء الأطلسي، بينما يكمن لدى البعض الآخر في تمتين الانتشار . من هنا سقطت في مفاصل كثيرة الفروقات بين الديمقراطيين والجمهوريين، ذاك أن هناك جمهوريين توسعيين يلتقون مع هيلاري كلينتون الديمقراطية ويختلفان مع دونالد ترامب الانعزالي الذي يُصرّح بوضوح أنه لن يستعمل القوة العسكرية إلا اذا تعرّض الأمن القومي الأميركي للخطر، ومن المنطق نفسه يدعو إلى التفاهُم مع روسيا بوتين في ما تشدّ كلينتون حبل الصِراع معها. هكذا رأينا جورج بوش الأب وفريق مؤثّر من الجمهوريين (هانغ بولسون وزير الخزانة، برنت سكوكروفت مُستشار الأمن القومي، ريشار أرميتاج وزير الدولة، دوغ المتس الناطق الرسمي أيام ريغن، ميغ ويتمان، ريشار حنا عضو الكونغرس وسوزان كولينز عضو مجلس الشيوخ، جون ستوبس، ريكاردو ريس، وغيرهم)، يُعلنون رسمياً تأييدهم لكلينتون إما عبر بيانات رسمية وإما عبر وسائل الإعلام خاصة نيويورك تايمز .غير أن التدقيق في مضمون مُبرّراتهم، بحسب تصريحاتهم، تضعنا في المُقدمة أمام قلق واضح بشأن “الاقتصاد، وموقع الولايات المتحدة في العالم”كما قال بولسون، بل وقلق أكبر عبّر عنه سكوكروفت بعبارة : “في هذه المرحلة المُضطربة” وفي حين وصف ويتمان ترامب بأنه “ديماغوجي”، كما قال دوغ ألمتس “لقد وضع نفسه ضدّ المُهاجرين والنساء والمثليين”، فإن ريشار أرميتاج ذهب أبعد من ذلك بالقول إن “ترامب ليس جمهورياً حقيقياً”، فيما يلتقي مع ما قالته الناطقة باسم حاكم نيوجيرسي: “لا يجوز للجمهوريين أن يدفنوا أنفسهم في الصمت”.
وإن كان ممثل نيويورك الجمهوري ريشار حنا قد برّر اختياره كلينتون بأنه “أميركي جيّد يُحب وطنه أكثر منه حزبه. مواقف يتعلّق القليل منها بحسابات الربح والخسارة في الانتخابات والكثير بقضايا أساسية، برؤى مُتناقضة، مطروحة منذ نشوء البلاد وتشكّلها كأمّة، ولكنها لم تكن لتبرز في التسعينات لأن الإشكالات كلها تصمت وتهدأ في حال القوّة المُطلقة والصعود وتبرز في مراحل التراجع والهبوط . فلم يكن لأحد أن يتساءل عن موقع أميركا في العالم بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وحرب الخليج، واستقرار القطبية الواحدة، ولم يكن هناك مَن يتساءل بقوّة عن الاقتصاد في مرحلة العولمة الأميركية أيضاً، وقد بدا أن الشركات المُتعدّدة الجنسيات المروية بصالصة أميركية (على حد تعبير هربرت شيلر) قد سيطرت على العالم، على نفط الشرق الأوسط كله، وعلى اقتصاد السوق.
كما أن مسألة الأسئلة الاجتماعية الخطيرة أزيحت إلى ما وراء ستار، وفي مقدمها مسألة الاندماج، ومسألة العلاقة بين المناطق الحضَرية والمناطق الريفية، ومسألة العلاقة بين المؤّسسات المالية والدولة والمجتمع. هذا إضافة إلى مسألة خطيرة تتمثّل في سيطرة اللوبي الصناعي العسكري على القرارين الخارجي والداخلي، تحقيقاً لما حذّر منه نيكسون في خطاب استقالته بالقول : “إذا ما استمرّ هذا اللوبي في هيمنته وصعوده فسيقضي على الديمقراطية الأميركية”. في الاقتصاد، لا يقول عاقل إن العولمة قد دفنت، ولكنها لم تعد أميركية صرفة، بل أصبحت إطاراً لساحات إنتاج ولسوق عالمي تتنافس عليه تكتلات اقليمية وعالمية مُتعدّدة، وفي إطار هذا التنافُس يتبدّى الاقليمي الذي يتجاوز القومي والوطني، ولكن يتبدّى أيضاً القومي الذي يعود إلى رأسمالية لا تتجرّد من المكانة القومية بل تدعمها.
ولعلّ دونالد ترامب قد فهم هذا التحوّل أكثر من سواه، وحاول أن يعود بالولايات المتحدة إلى هذا الإطار، تحليل تدعمه إشارة مُلفتة وهي أن الزعماء الجمهوريين الذين ذكرناهم أعلاه ينتمون إلى جيل بلغ الثمانينات أو التسعينات، جيل حلم الهيمنة المُطلقة.من هنا يُفهم معنى التصريحات التي قالت بأن ترامب ليس جمهورياً، وإنه على الجمهوريين ألا يلزموا الصمت إزاء سياساته، وذاك ما أكّدته دراسة علمية أميركية انتهت إلى القول إنه قومي رأسمالي ولكنه غير ليبرالي، لأنه ينفض أهم أسس الليبرالية وهو مبدأ التبادُل الحر والحدود المفتوحة.
ومن هنا تقول دراسة غربية أخرى إن الولايات المتحدة تشهد كل أربعين سنة تحوّلاً في الاصطفافات، فقد حصل هذا التحوّل مع ترشيح جون كنيدي بسبب قوانين الحقوق المدنية وما أعطته من حقوق للسود. والآن تحصل لأسباب أخرى مع ترامب الذي تجرّأ على تجاوز المكارثية التي تعتبر بأن مُجرّد التفكير بإعادة النظر بالنظام الأميركي هو انحراف توتاليتاري.يقودنا هذا إلى مسألة الاندماج وعلاقة الحضَر بالريف. وهو ما يُذكّر بأمرين هامّين: تجذّر إشكالية الاندماج في المجتمع والفكر الأميركيين. فحين تأسست في شيكاغو أول مدرسة فكرية للاتصال في الولايات المتحدة، بدأت عملها في دراسة كيفية مساهمة وسائل الاتصال في تحقيق الاندماج، وربطت ذلك بتقسيم العمل واقتصاد السوق والانتخابات، مُعتبرة المدينة مُختبراً اجتماعياً. ومن هنا ارتدت المدرسة الأميركية لقب: التجريبية والوظيفية. التجريبية كمنهج فكر وعمل، والوظيفية بناء على الدور المُلزِم في خدمة الشركات والأحزاب السياسية في الانتخابات.
في هذا السياق بنى لاسويل، الأب المؤسّس، نظرية الدعاية واعتبارها أقل تكلفة من العنف، ولكنه اعتبر في الوقت ذاته أنه لا يمكن لنا أن نصفها بالأخلاقية أو اللاأخلاقية إلا بقدر ما نصف بذلك مُحرّك مضخّة الماء.من جهة ثانية. مرتبطة بالأولى تطرح أيضاً إشكالية الهوية وإذا ما عدنا إلى صاموئيل هينتنغتون وكتابه ” تحدّيات الهوية الأميركية” الصادر عام 2002، نجد نظرية تمثّل طرفاً كبيراً من الأميركيين ومن الأنتلجنسيا في حينه. هذه الرؤية تقوم على التالي: إن ما يُحدّد هذه الهوية ثلاث: العرق الأبيض، الثقافة الأنكلوساكسونية والديانة البروتستانتية .ولهذه الاعتبارات الثقافية ولاعتبارات الجغرافيا فإن التهديد الحقيقي للهوية الأميركية إنما يكمن في أميركا اللاتينية. غير إن هذه الأميركا الإسبانية لا تصلح – بعد – لتشكيل “الكتلة المقابلة” الضرورية للحمة الهوية. بعد أن سقطت الكتلة الاشتراكية، ولذا فإن اصطناع صراع مع الإسلام من شأنه أن يؤدّي هذه المهمة.اليوم، يدخل دونالد ترامب المعركة شاهراً سيفه ضدّ اللاتينو والتطرّف الإسلامي معاً، مُتمسكاً بالبُعد الديني، ومُتّجهاً نحو البيض. موظّفاً لغضب شعبي يعيشه أهل الريف تجاه المدينة. هذا الغضب لم يخترعه ترامب ولكنه وظفّه، فهو مُتجذّر في المناطق الريفية لدى البيض من الطبقات الوسطى. ففي كتاب بعنوان: “سياسة الامتعاض “، تقول كريستين كرامر الباحثة في جامعة وستنكسون، إنها عملت خمس سنوات على عيّنات من جميع الشرائح في هذه المناطق، لتكتشف الكراهية، المرارة، الخيبة، وانهيار الأوهام. ولتجد أن حاكم وستنكسون نجح لأنه لعب على عنصر الخوف والمرارة إزاء المدينة. من أين يأتي هذا الغضب؟ من الوضع الاقتصادي أولاً، من أزمة الهوية التي تثيرها أكثر محاولات فرض نمط ثقافي واحد، من إحساس الناس بأنهم لا يأخذون حقوقهم، وعلى مَن يقع الحق؟ يقول ترامب: على المهاجرين، على الإسبان، على المسلمين، على هؤلاء النساء المُتعاليات. على النظام السياسي الذي لا يستمع إليكم ولا يُشرككم في القرار، على تدخّلاتنا في الخارج.هواجس يلبيها خطابه الاجتماعي والسياسي الانعزالي، فيعلن ابتعاده عن أية مواجهة مع الروس أو الصينيين أو حتى مع الأنظمة الخارجية، ويحافظ على عداء داعش. في حين تحاول كلينتون أن تكسب كل هؤلاء الذين شعارهم: “كل شيء إلا ترامب”، لتنفيذ سياسات أكثر تدخلاتية خاصة ضدّ روسيا، في آسيا ضدّ الصين، وفي العالم العربي، أكثر توظيفاً للإسلام المُتطرّف، وأكثر إدامة للصراعات المُسلّحة وتوظيفها في خدمة اللوبي الصناعي العسكري، وهي التي سجّلت خلال إدارتها لوزارة الخارجية أعلى نسبة من صفقات السلاح (80 ملياراً مع السعودية).لكن ثمة مصلحة أخرى للشركات والمجمّعات الصناعية تتمثّل في إخماد الصراعات المُسلّحة للإفادة من تكاليف إعادة الإعمار، ومن جهة ثانية للتمكّن من استثمار الغاز الهائل النائم في حوض المتوسط وفي أماكن أخرى من العالم.من هنا يُفهَم الانقسام الهائل بين الشركات وكبار رجال الأعمال بين ترامب وكلينتون، ومن هنا أيضاً نفهم هلع وول ستريت وانحيازها الأخير.لأجل هذا كله توظّف وسائل الاتصال الجماهيري بشكل مُبتذل لم يسبق أن شهدته معركة رئاسية، فكأننا أمام مسرح تراجيكوميدي، ولكنه ليس أبداً مسرحاً أبلهاً كما يتخيّل البعض. هو صوغ إعلامي يتبنّى نظرية لاسويل بشأن الدعاية ولكنها من جهة أخرى لا تغفل كل المدارس الأخرى التي تقوم على دراسة الجمهور وتدريب قادة الرأي واستخدام الرموز المؤثّرة، التي بلغت حد إنتاج فيلم يلتقي فيه ترامب مع السيّد المسيح ويُدين الأخير المُرشّح الجمهوري. بل حتى أن استطلاعاُ أجري مؤخراً في نيويورك قد دلّ على أن الناس يرفضون الشتائم المُتبادلة بين المُرشّحين، ولكنهم يعترفون بأنها أكثر ما يعلق بذاكرتهم.
كل ذلك لإثارة جمهور هو أقرب إلى الحشود العمياء التي تستجيب لهمومها الغرائزية والتجزيئية لصراخها وصراخ مُرشّحين: واحد مُعتاد على تلفزيون الواقع وأخرى مُعتادة على الصراخ والتمثيل ورفع الذراعين إلى الأعلى. ولعل واحداً من الأمثلة على ردّات الفعل الغرائزية هو تعاطف الناخبين المسلمين بل والإعلام العربي مع انتقاد ترامب لصمت الأم التي نعى زوجها إبنه الجندي القتيل.
فبدلاً من أن تنصبّ التعليقات على كون هذا الجندي قد قُتِل في العراق، إذن ضمن قوة مُحتلة، وأن نعود بذلك إلى مسؤولية احتلال العراق ، تحوّلت القضية إلى وسيلة شحن ديني ضدّ ترامب وشحن نسوي لصالح كلينتون . هنا أيضا تبرز حقيقة أخرى: نحن نستعر غضباً ضدّ مَن يرفض المهاجرين، ولكننا ننسى أن الأهم بكثير هو مَن تسبّب في هجرة هؤلاء المهاجرين.
فهل تساوي كل جوازات الولايات المتحدة مثلاً مدينة من فلسطين أو شارعاً من بغداد؟ مسجلين بألم أن ما يُحرّك هذه الملايين من المهاجرين في أميركا وفي أوروبا، هو خوفها على مصالحها وبقائها هناك وليس خوفها على مصالح وبقاء الوطن الأم. وإذا كنا نعطيهم بعض العذر في ذلك، فأي عذر لنا إذ نتبنّى ردّات فعل مشابهة، فلا نسأل ماذا سيكون تأثير برنامج ومفاهيم وارتباطات كل من المُرشّحين على قضايانا الوطنية وعلى نزيفنا الدامي؟الولايات المتحدة ستخرج من هذه المعركة بصورة أمّة مُنقسمة وغير واثقة من نفسها، أياً يكن الرابح، ولكن بما سنخرج نحن؟