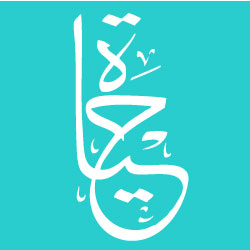لا يهتم الإعلام الفرنسي اليميني بما يحصل في فلسطين بحيث يورده كخبر ثانوي، في حين تمنح الصحافة اليسارية هذا الموضوع مساحة عنوانها الرئيسي (المانشيت)، وتخصص له أربعة مواضيع بين تقرير وتحليل يظهر بينها العنوان اللافت: «يتامى أوسلو مستعدون للتضحية بأنفسهم».
هل يعني ذلك تسرعنا المعهود في التهليل والتصفيق لأي موقف مؤيد أو حتى مهتم بالظاهر؟
يبدأ الجواب من معرفة الساحة السياسية، فاليسار الحاكم حالياً في فرنسا هو أكثر الجهات تأييداً ل«إسرائيل»، من رئيسها هولاند إلى وزير خارجيته اليهودي الصهيوني فابيوس إلى اللجنة المركزية للحزب التي لا تضم إلا الصهاينة.
لكن هذا اليسار فقد شعبيته ويقف الآن على بوابة الانتخابات. ويحتاج إلى عزف لحن يجتذب الجسم العربي الضخم من الناخبين. وأفضل لحن لذلك هو اللعب على الوتر الفلسطيني.
هذا أولاً، أما ثانياً فإن فرنسا الاشتراكية المترنحة اقتصادياً لا، ولم تجد إنقاذاً إلا من الدول العربية، فالسعودية خصتها بمنحة الجيش اللبناني على دفعتين، عدا عن صفقات التسلح الكبيرة مع الجميع، ومصر اشترت منها «الميسترال» التي تعثرت صفقتها مع روسيا، عدا عن صفقة طائرات الميراج مع القاهرة.
ثالثاً: عين باريس، على الساحة الإيرانية التي يسيل لعاب الجميع أمامها بانتظار رفع العقوبات ومرحلة الإعمار والبناء والتبادل التجاري.
ففرانسوا هولاند كان مؤيداً للاتفاق النووي، لأن الشركات، وفي مقدمتها «داسو»، تريده.
أما لوران فابيوس فكان رافضاً له، لأن «إسرائيل» لا تريده. إلا أنه تدارك أمره وكان أول من زار طهران بعد الاتفاق.
ويأتي الحل في المدخل الأفضل الذي لا يرفضه أحد: فلسطين.
مدخل يؤمن أيضاً لفرنسا استعادة شيء من شعبيتها في الشارع العربي بعد سياساتها الخرقاء في دعم الإرهاب والمساهمة في تدمير البلاد من ليبيا إلى سوريا إلى مجاهرة إيمانويل فالس ولوران فابيوس، بغض النظر عن ذهاب الإرهابيين إلى سوريا والعراق.
يومها صرح فابيوس للصحافة: لا استطيع أن أمنع شاباً قرر التطوع لمحاربة الديكتاتورية.
في النقطة الرابعة لا يبدو للمتفحص أن هذا الاهتمام يعارض نتنياهو في إعلان وفاة أوسلو «اليتامى» فهذا الرجل، العدو الاستراتيجي، هو الذي نادى بموت أوسلو منذ ترشحه الأول في بداية التسعينات، وكرس ذلك في كتاب مهم وعدة خطب وتصريحات. (ربما يكون من الغريب أننا نتفق معه في هذه النقطة!!!).
تطبيق هذا التحليل على فرنسا لا ينسحب على ألمانيا مثلاً، ولا على إيطاليا ولا حتى على بريطانيا الحالية، لذلك لا تبدو أوروبا موحدة في تعاملها مع قضايا المنطقة، غير أنها من تحت الطاولة موحدة تحت أمرة الشركات التي أطلق عليها ايناياسو رامونيه في بداية التسعينات لقب «سادة العالم الجدد».
الشركات هي التي تقرر مصير الجميع، وما حروب العصر إلا حروب الشركات: تفعيل التدمير لإعادة الإعمار والتنافس على بيع السلاح في الحرب والعقود الإنشائية والاستثمارية بعدها.
بعد الحرب العالمية الثانية جلس الأمريكيون والروس وبريطانيا وفرنسا إلى طاولة يالطا وتقاسموا العالم.
بعد حروب التسعين، طرد الأمريكي الجميع من على الطاولة وتربع فوقها. اليوم استطاع الكثيرون أن يعودوا إلى مقاعدهم وفي المقدمة روسيا والصين، ليتشكل عالم لا يشبه عالم الخمسينات ولا عالم التسعينات، لكن أوروبا تتمثل هذه المرة بألمانيا لا بفرنسا. رغم المحاولات اليائسة للأخيرة. وكأن برلين تثأر لهزيمتيها النكراءين، كما ثأرت طوكيو.
الأمريكي يأتي وفي جيبه مقررات مؤتمر الشراكة عبر المحيط الهادئ الذي لم يكن إلا مؤتمر الشركات وتحريرها من كل قيود السيادة الوطنية للدول، بالهيمنة على التنظيمات التي تتحكم في التجارة العابرة للقارات الكاسرة للحدود والجنسيات.
من دون أن ننسى أن هذا المؤتمر يكرس أيضاً إدارة واشنطن وجهها للمحيط الهادئ وظهرها لنا.
أدراج طاولة يالطا الثانية، التي ربما يكون اسمها جنيف أو أي شيء آخر، مملوءة بمطالب الشركات وعروضها، واستراتيجيو الاستثمار يقفون وراء الستائر يمسكون بحبل الكراسي بأيديهم كما مسرح الدمى، ويلقنون عبر «الإيرفون» كما يفعل مديرو البرامج التلفزيونية مع مذيعاتنا.
د.حياة الحويك عطية
إعلاميّة، كاتبة، باحثة، وأستاذة، بين الأردن ومختلف الدول العربية وبعض الأوروبية. خبيرة في جيوبوليتيك الإتصال الجماهيري، أستاذة جامعيّة وباحثة.