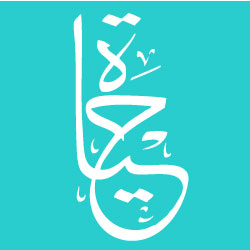قبل شهر من لقاء ميركل وأوباما كان جي زايانغ. وكانت صفقة العصر لأنها وزن ثقيل في توازنات العصر.
كانت أوروبا تفتخر دائماً بميزة ستراتيجية: تسبح في السياسة الدولية وذراع في الأطلسي وأخرى في المتوسط. هكذا أراد لها شارل ديغول، ومعه أنصار الاستقلالية – أن تشكل ثقلاً وازناً بين العمالقة. أوروبا لم تعد ديغولية منذ يسارها الميتراني ويمينها الساركوزي، رغم نداءات من يوافقون جان بيير شفينمان: ارتمت في ذيل التنورة الأمريكية وكرّست ذلك الإلحاق منذ عام،1991 وحتى قرار ساركوزي بالعودة إلى الأطلسي وقرار هولاند بقيادة الربيع العربي عبر برنار هنري ليفي. اليوم فلاديمير بوتين تلقف الرسالة عينها: نحن نسبح وذراع في الغرب وأخرى في الشرق، إنه قدر الجغرافيا. وإذا ما هدد أحد بإقفال النافذة الغربية، نفتح الشرقية وهي أسطع شمساً.
بين الرسالتين متغير مركزي: الأمريكي لملم ذيل تنورته الأطلسية منذ عام،2009 وقرر الاتجاه إلى فردها فوق المحيطين الهادي والهندي، حيث “أولويات الدفاع للقرن الواحد والعشرين” وفق تعبير التوجيه الاستراتيجي الذي أصدره أوباما عام 2012 لوزارة الدفاع الأمريكية بعد مشاركته في قمة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مدينة بالي الإندونيسية. هناك تقع المواجهة مع الصين وروسيا ولا فاصل إلا الماء لا تعكرّه في الشرق إلا هاييتي. بينما تحكمه في الجنوب جزر أستراليا والفيلبين وإندونيسيا وماليزيا وسريلانكا وفي مقابلها على اليابسة تايلند وكمبوديا وبرمانيا والبنغال والهند، وصولاً إلى باكستان وإيران. هذا القوس هو قوس الصراع بثرواته وموقعه وخلافاته الحدودية. هو الخط الذي تخطط بكين لنشر أسطولها البحري عليه، فيما أطلقت عليه اسم “عقد اللؤلؤ” وهو ما تسعى واشنطن بكل ثقلها لعرقلته، بوسائل عدة منها الاضطرابات الأمنية في الدول المذكورة وليس انقلاب كمبوديا بآخرها. وعليه فثمة مصلحة مباشرة لروسيا في دعم المشروع الصيني هناك واستكماله جغرافياً بدعم عودتها هي إلى بحر عُمان وخليج العرب والمتوسط.
الصين بحاجة إلى تطوير مصادر تموينها من الغاز هي التي استوردت في العام الماضي 53 مليار متر مكعب أي بزيادة 25% عن العام الماضي. وبشكل خاص التوجه نحو مصادر لا تقع تحت السيطرة الأمريكية، خاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبما أن العقد الجديد ينص على 35 مليار متر مكعب، فإن الحاجة الأخرى تنخفض إلى 18 مليار فحسب. خاصة ان تنامي الحاجة الصينية قد أخذ في الحسبان في نص الصفقة الثلاثينية. كذلك فإن روسيا بحاجة إلى سوق شرقي للنفط يترجم تهديد ميدفيديف قبل أسبوعين: “إذا حصل الأسوأ في أوكرانيا نرسل الغاز إلى الشرق”. (طبيعي أنه لم يصرح بذلك إلا بعد علمه بنضوج الصفقة مع الصين وقرار بوتين بتوقيعها بأي ثمن حتى لو في الرابعة صباحاً).
الصين أيضاً بحاجة إلى تسريع النمو في مناطق الشمال المحاذية لروسيا والبعيدة عن موقع الصراع: المحيطين (الهادي والهندي) وهي مناطق صناعية، تفتقر إلى مصادر الطاقة، وعليه تعتمد على الفحم الحجري ذي الآثار الكارثية في البيئة. كما أن بكين بحاجة إلى تطوير البنى التحتية في مجال الأنابيب وغيرها. وهذا ما خصصت له الاتفاقية المذكورة مبلغ 50 مليار دولار. منها 25 مليار دولار تقدمها بكين بشكل فوري لتطوير شبكة الأنابيب الواقعة على المنطقة الحدودية بين الدولتين الجارتين ومد خطوط أنابيب بطول 2500 كيلومتر لضخ الغاز الطبيعي من حقلين في سيبيريا إلى المناطق الصناعية الواقعة في شمال الصين، ما سيؤدي إلى تنمية المنطقتين السيبيرية والصينية، وربطهما بشكل طويل المدى.
وكما أن الصين بحاجة إلى الدعم الروسي في المواجهة في الشرق والجنوب فإن روسيا بحاجة أكبر إلى الدعم الصيني في المواجهة مع الغرب عبر أوكرانيا، حيث يتهددها أكثر من خطر ليس أخطرها العقوبات السياسية، فالاقتصاد أهم، وبوتين من جيل لم ينس أن الاتحاد السوفييتي انهار اقتصادياً لا سياسياً. وفي الاقتصاد توقع بحصول كساد اقتصادي في ظل نسبة نمو مقدّر ب 2.0 في المئة خلال العام الحالي، وتخوف من بلوغ حجم الاموال النازحة هذا العام رقم 150 مليار دولار، وفق تقديرات البنك الدولي أي ما يعادل ثلاثة اضعاف مثيلتها في العام الماضي. ما سيعقد دورها في الأسواق الدولية وقدرتها على استكمال البنى التحتية اللازمة لمونديال،2018 صحيح أن الصفقة لن تلغي هذه المخاطر، خاصة أن قيمتها لا تتجاوز ربع الصادرات الروسية إلى أوروبا، ولكنها ستضع في بوتين سلاحاً قوياً خلال اجتماعه إلى أوباما وميركل في يونيو/حزيران المقبل. خاصة ان عض الأصابع متبادل بينه وبين الأوروبيين الذين ينقسمون على العلاقة مع روسيا بناء على تقدير مصالح استراتيجية واقتصادية، فألمانيا التي يصلها السيل الشمالي مباشرة والنمسا التي يصلها السيل الجنوبي بعد عبوره اليونان وإيطاليا وهنغاريا، ليستا كالآخرين في حساب المصالح. في إطار يفهم منه مثلاً سبب رفع فرنسا الصوت في مجلس الأمن بشأن سوريا غداة إبرام صفقة بكين.
إنها الحرب الباردة الجديدة ترسم ملامح جديدة للعصر عبر إقامة توازنات جديدة وساحات صراع جديدة.