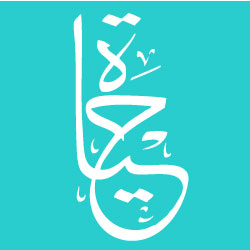“بعد أن همشتها المبادرة الروسية الأمريكية بشأن نزع السلاح الكيماوي في سوريا، تحاول فرنسا أن تسمع صوتها كي تتجنب صفقة جديدة من وراء ظهرها، وذلك بأن تصرّ على المرحلة الانتقالية متذرعة بتحسين الوضع الإنساني. خاصة أن فرنسا لا تملك الإمكانات التي تجعلها تتدخل منفردة. وقد أصبحت يدا فرنسا مغلولتين أكثر في سوريا بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني”.
هذا ما كتبته صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، لتؤشر إلى مرحلة، إذا ما أمعنّا النظر فيها، أعادتنا أكثر من قرن إلى الوراء. لنعد أربعة مفاصل كان كل منها نظاماً عالمياً جديداً انعكس على وضع العرب. الحرب العالمية الأولى أفرزت نظاماً جديداً أخرجنا من الاستعمار العثماني إلى أسر الاستعمار الأوروبي خاصة البريطاني الفرنسي. وبدا كأن هذه الوصاية قدر مطبق، خاصة بعد سحق الثورة السورية (في بلاد الشام) ومن ثم العراقية. والحرب العالمية الثانية أفرزت نظاماً جديداً نقل العالم إلى ثنائية القطبين، التي جعلت أوروبا شطرين، كل واحد ملحق بقطب منها. وعندما أدرك الرئيس الراحل عبد الناصر اللحظة وعمد إلى التمرد على هذا القدر، حاول الاستعمار القديم بكل شراسة أن يدافع عن بقائه في هذه المنطقة الحساسة فكان عدوان السويس. محاولة فرنسية بريطانية “إسرائيلية” لتثبيت الهيمنة الأوروبية. لكن القوتين الجديدتين لم تسمحا بذلك وخرجت أوروبا من المنطقة لتدخلها أمريكا من جهة، والاتحاد السوفييتي من جهة أخرى.
انهيار الكتلة الاشتراكية، أفرز نظاماً عالمياً جديداً تجلت ترجمته وتثبيته في حربي الخليج واحتلال العراق، فسارعت أوروبا إلى الانخراط في حرب 1991 ظناً منها بأن ذلك سيمنحها فرصة العودة إلى منجم الكنوز الطبيعية والاستراتيجية، لكن الامبراطورية التي انفردت بالعالم، انفردت بالمنطقة العربية، لتجد أوروبا نفسها مرة أخرى خارج الكعكة (وهذا ما كان يدركه شيراك وشرويدر فعارضا حرب 2003).
اليوم تفرز التطورات الدولية نظاماً عالمياً جديداً، يعود الروسي والأمريكي ليتواطآ على عدم تقاسم الكعكة مع كثير من الشركاء، إلا من يفرض نفسه، كالصين مثلاً. وبعض الآخرين كل بحسب حجم تأثيره.
بهذه المقاييس، لن يكون لأوروبا شيء يذكر، إلاّ بالعثور على مدخل استباقي، ولو جزئي، وهذا ما أدركته الحكمة البريطانية وأوكلته بقصدية خبيثة إلى مجلس العموم، بدليل أن بلير لم يستمع إلى هذا المجلس عام 2003.
غير أن متغيراً خطراً لا سابق له يلف المنطقة هذه المرة، ألا وهو خروج العرب -حتى بدولهم القطرية وجامعتهم المفرّقة الدمية- من ساحة التوازنات الإقليمية. وكعادتهم الغالبة، فإن شعورهم بالضعف والخوف لا يدفعهم إلى الالتفاف حول بقائهم شعوباً وأمة، بل يدفعهم إلى تلمس الحماية لدى قوة أخرى: تركيا أو إيران أو “إسرائيل”.
وإذا كان السؤال البديهي اليائس يصرخ: أين مصر؟ أين العراق؟ أين سوريا؟ أين الجزائر؟ (والباقي ملحقات كقوى مركز)، بل وحتى أين السعودية؟ فإن الجواب لن يضاعف إلاّ اليأس. خاصة أن من دمر القوة العربية هذه المرة هم العرب أنفسهم، بحيث لم يحلم واضعو نظرية التدمير الذاتي يوماً بأنها ستنجح كما نجحت، وما زالت تتأجج أكثر فأكثر.
ستخرج سوريا من أزمتها، بعد أن أعادت بدماء أبنائها رسم خريطة يالطا الجديدة. وبعد أن أفرزت نظاماً عالمياً جديداً، نظام يمكن للحكمة السياسية المنتصرة أن تستغله لإعادة بناء قوة عربية كبرى في المشرق العربي. ولكن السؤال يبقى عما إذا كان هناك من يريد لها هذه القوة؟ من يريد للعرب أن تقوم لهم قوة تتمسك بالسيادة والكرامة؟ وإذا ما كان الجواب بالنفي، فإن المنطق يقول إن الحل ليس قريباً، وليس قبل أن تتواصل النار في أكل الخضرة السورية في أكثر من مكان وقبل أن تصل إلى الهشيم العربي في أكثر من مكان.
أوليس ذلك مغزى الصوت الفرنسي العالي؟ واليد الفرنسية الخفية الصامتة التي تتشابك مع اليد “الإسرائيلية” وغيرها لتدعيم استمرار النار طالما أن الاستعمار الأوروبي القديم سيجد نفسه خارج لعبة المصالح؟
أوليس ذلك ما يريده الأمريكيون أيضاً، ووراءهم بعض العرب؟
في هاليفاكس قال جون ماكين عرّاب الإخوان عن الرئيس الأسد: “لديه السلاح، لديه الجيش، لديه حزب الله، دعم موسكو ونجاح قواته على الأرض، فلماذا بحق الشيطان يذهب إلى جنيف ليقر الانتقالية؟”، وفي هاليفاكس أيضاً قال جورج صبرا: “من غير الممكن أن نحصل على الورق ما لم نحصله على الأرض”.
إذاً، المطلوب أن يستمر الصراع على الأرض، أن يقدم دعم إضافي للتخريب حتى الإنهاك والدمار علّ معارضة هاليفاكس تحصل شيئاً على الأرض لتحصل بعده على الورق.