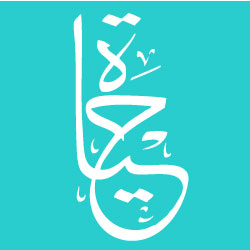لم يبق الا الجراد كي تكتمل مآسي هذه المنطقة من العالم التي هي بلادنا. والطريف أن الجراد مرتبط عندنا بأيام سفر برلك، المرحلة الأكثر قسوة في تاريخنا المعاصر. مرحلة ما زلنا نسمع عنها حكايات الجدات: جدات جيلنا وليس الجدات اللواتي من جيلنا. كان العثماني يريد انقاذ امبراطوريته المفلسة من المال والرجال، فجند أجدادنا بالقوة وبالسخرة، وصادر كل ما كان لدينا من غذاء وخاصة الحبوب ليسد جوعه وجوع جيشه.
مات عشرات الآلاف حربا ولكن من مات جوعا كان أكثر. ومن حكايات جدتي الى روايات توفيق يوسف عواد، نرى الحال السوريالي الذي يجعل البشر يأكلون الحمير ويأكلون الجثث النافقة فيتسممون ويلحقون بها، والمرأة التي تضع كمًا من الحصى في وعاء وتروح توقد تحته موهمة أطفالها أنه طعام الى أن تموت واياهم بهدوء الترقب. نرى في بيوت جبل لبنان والجليل وأماكن من سورية المخابئ السرية، وفي مزرعة أهلي واحد منها، تُحفر في الأرض وتُغطى بالطين لاخفاء القمح عن أعين جنود الانكشارية الذين يصادرون كل ما يجدون.
يومها هرب الآلاف من الرجال الى الاميركتين ومن هناك كتب جبران خليل جبران نصه الشهير: ” مات أهلي” : ” مات أهلي جائعين، ومن لم يمت منهم جوعا فني بحدّ السيف، وأنا في هذه البلاد القَصيِّة أسير بين قوم فرحين مغبوطين يتناولون المآكل الشهية والمشارب الطيبة وينامون على الأسرّة الناعمة ويضحكون للأيام والأيام تضحك لهم… ماتوا وأكفهم ممدودة نحو الشرق والغرب وعيونهم محدقة بسواد الفضاء ” كان وجع مبدع النبي أن أهله يموتون في حرب الأمم لا في حربهم، يموتون لأجل مصالح غيرهم لا لأجل مصالحهم يموتون موتا صممه غيرهم ” نكبة بلادي نكبة خرساء نكبة بلادي جريمة حيلت بها رؤوس الأفاعي والثعابين”.
ما أشبه الأمس باليوم، وقد عاد العثماني وعاد الجراد، الأول يجند ويسلح وينقل مصانع حلب الى تركيا والثاني يهدد الأرض ومحاصيلها. لكن سقوط المطر هذا الأسبوع قلل من خطر الجراد – هكذا يقول الخبراء والمزارعون – وربما عاد فاشتد مع اشتداد الحر، عندها ربما تنفع المبيدات وربما عدنا الى واحد من الأجواء التي رافقت سفر برلك. خاصة وأن ثمة أجواء أخرى قائمة وبتماثل رهيب، فهي حرب الأمم، وهم العرب ينقسمون بين مؤيد لهذا ومؤيد لذاك، هذا يقاتل لأجل العثماني وهذا يقاتل لأجل الفرنسي والبريطاني… وما يهم اذا اختلفت أو أضيفت بعض الأسماء.
لكن ثمة ملمح كان أفضل أيام سفر برلك، رغم الجراد: كان العرب موحدين ضد الغريب وفي مطالبتهم بالحرية الوطنية، كانت المشانق التي يعلقها جمال باشا في ساحة المرجة في دمشق وساحة البرج في بيروت ترفع على أعوادها المناضلين القوميين من مختلف مناطق سورية الطبيعية، من أقصاها الى أقصاها، ومن مختلف الطوائف والمذاهب، من دون أن يتوقف أحد عند ذلك لانه كان طبيعيا، وعندما انتقل الاستعمار من تركيا المهزومة في حرب الأمم الى فرنسا وبريطانيا المنتصرتين، كان الثوار الذين ساروا وراء وزير الدفاع السوري، الشهيد يوسف العظمة، ومن ثم وراء قائد الثورة السورية سلطان باشا الأطرش، ينتمون أيضا الى مختلف مناطق سوريا الطبيعية والى مختلف المذاهب والطوائف. كان جبران ينادي أهله في كتاباته أيها السوريون قاصدا بها أهل سوريا الطبيعية كلهم، لأن الجميع – لا جبران وحده – كانوا يعتبرون هذا الأمر مسلمة لم تكن قد دمرتها بعد سايكس – بيكو. لترسخ الكيانية المريضة ما رسمه الانكليزي والفرنسي على ورقة.
كان الغريب هو الذي يقتلنا أو الذي يصمم موتنا، ولم نكن نحن من ينفذه كما نفعل اليوم، وبذا تكتسب صرخة جبران معنى اضافيا: ” مات أهلي وأهلكم أيها السوريون، فماذا نستطيع أن نفعل لمن لم يمت منهم”؟