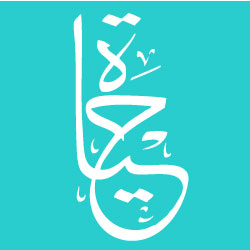رغم كل ما يبدو من تشابه بين ما يسمى بالربيع العربي، فان لكل حالة خصوصياتها التي تفرض تناولها من زاوية خاصة.
الأزمة الأردنية الأخيرة، لا تعكس الا مآلا لأسلوب ادارة الاقتصاد على مدى السنوات الطوال الماضية، منذ اقنعوا الناس في هذه البقعة أنهم لا يستطيعون بناء دولة الا بالمساعدات الأجنبية، ومنذ أن أقنعوهم بأن الأردن بلد من دون موارد ولا امكانات: لم يعد الشمال أرض حوران: ” اهراء روما ” ولم يعد الجنوب يموّن السلطنة المملوكية بالحبوب والفواكه، حتى ولو وثّق ذلك يوسف درويش غوانمة في كتاب قيم.
لم يعد التنوع المناخي الذي لا مثيل له في العالم فرصة استثنائية للانتاج الزراعي، واقتنعنا أن البلد يفتقر الى الماء في حين يعوم نصفه على بحيرة مياه جوفية، واقتنعنا أن الأرض التي كانت تسمى “وادي البطم” ويبني فيها الأمويون قصرا للصيد في غاباتها هي “صحراء ” لا متصحرة، ولم يقرأ احد فوزي زيادين ليعرف ذلك. لم نسمع قصص الجدّات عن الجدود وأصبح طموح الشباب كرسيا وراء مكتب ( يحلو أكثر اذا كان حكوميا حيث لا عمل بمعنى الكلمة)، وأبعد ما يكون عن الطموح الانتاجي الذي يجعل منه ملكا. تبنينا نظرة البداوة الى الزراعة رغم أننا بلاد زراعة منذ فجر التاريخ، ولم يقل لنا أحد أن الفرنسيين يقولون إن الزراعة هي نفط فرنسا، بل قال لنا فهد الفانك يوما: ليذهب القمح الى الجحيم! فصفقنا له. سافر أبناؤنا إلى الخليج، فقررنا أن علينا أن نعيش النمط الخليجي من دون أن يكون لدينا لا نفط ولا غاز، بل مجرد راتب عال يتحول الى تهديد في حالات كثيرة. تحولنا الى مجتمع استهلاكي بامتياز، في حين أننا لسنا مجتمعا انتاجيا بأي مقياس من المقاييس. وعندما ألحقتنا العولمة باقتصاد السوق، سعينا الى الخصخصة، وكان معها ما عرف من نتائجها في كل المجتمعات: الفساد. لم يكن للمساعدات أن تنفق في تنمية مستدامة، لأن من يساعد لا يمكن أن يقبل بذلك، فليس بين المساعدين جمعيات خيرية ولكل شيء ثمنه. ولم يكن لمستثمري اقتصاد السوق أن يقلقوا بالعدالة الاجتماعية واتساع الهوة بين طبقتين تلغى من بينهما الطبقة الوسطى الضامنة للانتاج المعنوي والمادي والفكري. أما المساعدات فكان لها أن تقفل كأنبوبة عندما يراد ممارسة ضغوط على البلد وسياساته ومصالحه.
اليوم نحن نعيش أزمة، وسببها لا يقتصر على هذا البعد الاقتصادي الخطأ الذي بنينا حياتنا عليه بل على أبعاد متعددة، وليس من يستطيع القول إن الناس غير محقين فيما يطالبون به في المنتديات وفي الشوارع. خاصة أنهم استطاعوا أن يحافظوا في حراكهم – حتى بعد رفع الأسعار – على قدر عال من السلوك الحضاري، ولم ينزلقوا الى العنف كما حصل عند غيرنا. واذا كان لا بد من كلمة حق في الناس المتظاهرين الغاضبين، فلا بد أيضا من كلمة حق في الحكومة( حتى ولو طالب بعضهم باستقالتها) حيث ان هذه الحكومة، وبشخص رئيسها تحملت مسؤولية نادرة: أي تحملت أخطاء من سبقوها وتحملت عبء قرارات موجعة لاصلاح هذه الأخطاء. وربما تكون هي المرة الأولى التي نسمع فيها مسؤولا حكوميا مكلفا ( لا ديكتاتورا أو زعيما) يتحدث بصيغة الأنا: أنا فلان أتحمل مسؤولية أمانة عليا، عُهد بها اليّ، وقرار لا أحمّل مسؤوليته لغيري من مواقع ومؤسسات. وللحق إنه خطاب لا يجرؤ مسؤول على التحدث الاّ به في الدول الديمقراطية، في حين ان خطابنا، ككل العرب، هو دائما: “نحن “، ” الحكم “، “الوطن”..الخ، من صيغ تبعد المسؤولية الشخصية عن صاحب القرار.
لذا ربما يكون في هذين الأمرين: التحول الاقتصادي نحو العلاج الداخلي ( ولو مرغمين ) ومبادرة مؤسسات منها البنوك المحلية على دعم هذا الاتجاه، والتحول الاداري السياسي في اتخاذ القرار وتحمل عبئه، شيء من بدايات التغيير، الذي يغذي الطموح الى خطوات تالية تتمثل في التجرؤ نفسه على ملفات الفساد، وعلى فتح ساحة الحريات السياسية بمعناها الحقيقي الذي يؤدي الى نشوء أحزاب حقيقية تتنافس في البرامج وفي الحساب.