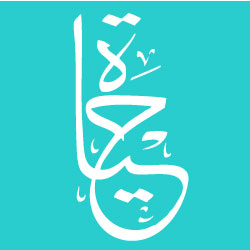في هذه المرحلة من تاريخ المجتمعات العربية، يعلو الصراخ حول ما يريده المواطن من الدولة. وهذا امر ايجابي يسمونه الوعي المطلبي. لكن هذا الوعي يبقى وعيا مزيفا اذا لم يستجب لسؤالين :
من هي الدولة؟
وماذا تريده الدولة من المواطن؟
الدولة هي الهيكل السياسي الدستوري المؤسساتي للامة بشعبها وبارضها، او للمجتمع عندما تكون الامة مجزاة كما هو حالنا. وبالتالي فان كل مواطن منخرط فيها بوظيفة او باخرى، بموقع او باخر. من هنا فان ما تريده الدولة من المواطن هو الالتزام بواجب موقعه ايا كان، وزيرا او ماسح احذية ( وربما كان الثاني ارقى من الاول اذا كان اكثر التزاما).
اعود للتو من وزارة التعليم العالي، حيث مضى علي شهر وانا اسعى لمعادلة شهاداتي. وللحق اقول الملاحظات التالية، حول النظام وحول الاداء، وليتسع صدر المعنيين لتقبلها.
من حيث النظام : تدخل معاملة المعادلات فاذا بخريج جامعات لا نعرف لها اسمها ولا عنوانا، لم يصلها المنتسب الا بريدا وعبر الوسيط الذي اخذ منه ثمن اللقب وربما احيانا دبر له من يكتب الرسالة، يعامل امام الموظفين مثله مثل خريج برينستون او اكسفورد او السوربون ( كما هو حالي).
وانا لا اقول هنا انه يمكن ان يترك للموظف، ايا يكن موقعه ان يستنسب، بل لا بد من ان تقوم الوزارة بتصنيف الجامعات العربية والعالمية، فئات ( أ،ب،ج الخ….) وتوضع لكل منها شروط مختلفة عن الاخرى. فلا يعقل ان يطلب من خريج السوربون مثلا وثيقة تثبت انه يجيد الفرنسية ( لانه لا يدخل الجامعة بدون ذلك ) او ان يطلب منه وثيقة انتظام، (لان مفهوم الانتساب غير وارد في هذه الجامعة وما يماثلها). ولا ان يطلب من شخص تخرج منذ ثلاثين سنة وعمل في مدارس وجامعات منها اردنية رسمية، ان ياتي بنموذج مصدق حديثا لشهادته القديمة، علما بانه صدقها ثلاث او اربع مرات سابقا.
بالمقابل لا يعقل ان يتم اي تساهل مع ما تبصقه علينا الجامعات التجارية المجهولة الهوية ( واذكر على مسؤوليتي انني تلقيت عروضا من جهات عربية، وعبر الايميل، عندما سجلت للدكتوراه في فرنسا، بتامين دكتوراه من جامعة عربية مقابل ثلاثة الاف دولار وبدون تعب).
اما كيف عرفوا انني انوي الذهاب، وكيف عرفوا ايميلي فهذا ما لا اعرفه لكنه يؤشر الى ان هناك شبكات ما تعمل في هذا المجال. ليس منا من لا يعرف دكتوراه فرخت فجاة على سعيد او سعيدة حظ لا تتجاوز كفاءاتهما البكالوريوس – ان تجاوزت – فاذا به د. وينافس خريجا نقب عينيه في اكسفورد او في كامبردج او في السوربون. خاصة اذا كان هذا الخريج في بداية حياته المهنية مسلحا بعمله وشهادته فحسب.
تورد كل هذه الملاحظات، فيفهمك مسؤول ويعود الاخر فيردك الى البداية، حتى تضطر الى الذهاب الى المسؤول الاول، وهنا اشكر الوزير الاكاديمي الكبير الدكتور وجيه عويس لانه تفهمني دون ان يتساهل معي، ودون ان يقفز فوق مرؤوسيه.
انتقل الى الجانب الاداري، ففي زياراتي المتعددة الى الوزارة، لم امر بمكتب الا ووجدت فيه اماكن فارغة.. هذا خرج ويعود بعد قليل… وهذه متعبة وتريد ان ترتاح، وهذان مشغولان بالحديث المتبادل ولا يردان تحيتك. والطامة انك تصل الى مكتب الاستلام وفيه اثنان : الاول غائب، والثانية تعطيني ورقة لاملاها وتقول لي انها تريد ان تقفل المكتب لانها خارجة، حسنا : ابقى لاملأ ما تريدين الى ان تعودي. – لا املئيها في الخارج في الممر وانتظريني… تذهب الى المسؤول عنها، فيفاجا، لانه سمح لها بالخروج على ان تحل اخرى محلها، وليس باقفال المكتب. لكنها تلوح له بالمفتاح وعليه ان يبحث عن الاخرى. في حين تجرني هي الى مكتب اخر في طريقها، لتوقّع، فاذا فيه هو الاخر ديسك شاغر من صاحبه.
كيف تسير الامور اذن؟ ببساطة واحد يعمل عن عشرة وعشرة يتخذون من الوظيفة الحكومية ( تكيّة) وعندما يخرجون يصرخون عتبا على الدولة. من هي الدولة؟ هي انتم وانتم من يهلهلها ويفرغها من انتاجيتها. ولذا فان المسؤول – اذا كان مخلصا- يشكو لك اكثر مما تشكو له، واذا لم يكن كذلك سار في السحجة.
اي ربيع نتحدث عنه، اي حراك، واية اصلاحات، ان لم تبدا بامطار غزيرة تجرف الكسل والبلادة وتروي مفهوم الانتاجية، تجرف مفهوم الراتب – تحصيل الحاصل، والعمل على الله. وهي عملية بناء لا تبدا بموظف عيّن في وزارة ( بواسطة عمه او خاله او بناءا على توازنات ما) وانما بعملية تربوية اساسية من الروضة الى الجامعات. وبسياسة دولة تخرج من اطار المساعدات – المنّة والمشروعية المشتراة الى سياسة انتاج يحرر الوطن وسيادته وقراره وبالتالي المواطن.