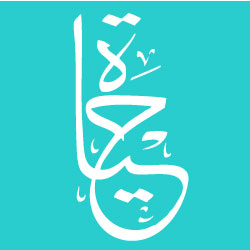بين الدولة والحكم والنظام، ثمة اشكالية كبرى في المصطلح لدى العرب، تعكس اشكالية كبرى في الواقع السياسي. وبين الدولة والدين والعرق، ثمة اشكالية اكبر لا اتعكس فقط اشكالية في الواقع الحالي بل تشكل تهديدا وجوديا خطيرا للمستقبل.
الدولة كيان مقدس لا يجوز المس به في اي مجتمع من مجتمعات العالم، اما الحكومة او الحكم فهيكل مؤقت من اولويات الواجب الديمقراطي مراقبته، ومحاسبته سلبا او ايجابا بحسب ادائه، والتعرض له لاسقاطه في حال كانت نتيجة الحساب سلبية.
هذا من جهة، اما من الجهة الثانية فان الانتماء للدولة لا يجوز ان يرتبط باي انتماء اخر، ديني او عرقي او اتني، علما بانه من واجب حكومة الدولة تامين حرية المعتقد وممارسته، وحرية الخصوصيات الثقافية التي من شانها اغناء الثقافة الوطنية لا تفتيتها.
نخرج من النظرية الى الواقع، لنرى ان المعارضات العربية، شانها شان الحكومات العربية قد وقعت منذ عقود في خلط خطير بين الدولة والحكم، لاننا لم نتجاوز عصر لويس الرابع عشر و “انا الدولة والدولة انا”، ولذلك كان الحاكم يقيم تماهيا بين مصالحه وارادته والولاء له وبين مصالح الدولة وارادتها والولاء لها، فتكون النتيجة ان الشعوب ضحية الاقصاء تجد نفسها بين ثلاثة خيارات: اما الالتحاق بركب مصالح النظام الحاكم والتحول الى متعهدي عقود باطن لمصالحه، واما الانسحاب والانكفاء الى السلبية والتخلي، واما المواجهة مع الحاكم ونظامه: غير ان اخطر ما في المسالة هنا ان هذه المواجهة كانت تنقسم الى خطين: خط يعرف ان من حقه اسقاط الحكم ونظامه، والحفاظ على الدولة ومنجزاتها وكيانها ووحدتها ومصالحها، وخط اخر يندفع الى رمي الطفل مع ماء الحمام كما يقول المثل الفرنسي، فاذا تدمير الدولة وتحطيمها وسيلة الانتقام من الحاكم او وسيلة التكسب لدى اعداء الوطن. ولم يكن غريبا ان يكون الخط الاول هو خط اكثر الناس تضحية وتحملا للضربات من الطرفين.
هذا الواقع ينطبق اليوم على ما يسمى الثورات العربية، ونحن لا نخجل من القول انها ليست ثورات، وليست ربيعا، انها عواصف حراك شعبي قوي، قد ينجح المخلصون فيها في تحويلها الى ثورات، وقد ينجح المندسون والجهلة والعملاء في توجيهها وجهة الخراب والدمار ليس الا. عواصف قد تسبق ربيعا، وقد تسبق دمارا اعصاريا لا نخرج منه لسنوات بل لعقود.
مسؤولية من؟ يقول الجدليون. لا شك انها مسؤولية الانظمة التي قمعت وافقرت والاهم منعت الجدل الفكري والسياسي الذي يؤدي الى تشكيل الاحزاب السياسية القادرة على ان تقود الشعوب، وتقدم البديل في حال اسقط الحكم. ولكنها ايضا مسؤولية هذه الاحزاب نفسها، ومسؤولية من يدعون انهم مثقفون ومن يحلو لهم اسم “الناشطون”.
والحال هذه نقف امام البديل الجاهز: الفوضى، او الحركات الاسلامية التي تبدو الاقوى على الساحة الشعبية. وهنا لا بد من مواجهة صريحة. فلا جدال انه من حق الحركات الاسلامية ان تمارس دورها السياسي بحرية، شانها شان الحزب الديمقراطي المسيحي في المانيا او في ايطاليا. ولكنه ليس من حقها ان تصادر الاخرين او تلغيهم. والاهم من ذلك كله انه لا يجوز ابدا ترك الامور تصل الى تبني خيار الدولة الدينية، او تحديد الانتماء للدولة بالانتماء الى الدين، اذ يكفينا لذلك ان ننظر الى استحقاق سبتمبر القادم بشان الدولة الفلسطينية، لنرى انه يدور، كله، حول الاعتراف بيهودية دولة اسرائيل، وما من امر يخدم هذا المطلب اليهودي العنصري، الا نشوء دول اسلامية (او مسيحية) في منطقة الشرق الاوسط المحيطة باسرائيل. امر يبدو وكانه يشغل بال بعض المفكرين الاوروبيين التقدميين اكثر مما يشغل بالنا نحن. وقد راينا بعضهم يتساءل بقلق عن التحول في تصريحات الان جوبيه وموراتينوس (والشركاء الاوروبيين) حول مسالة يهودية الدولة. ففي 18 تموز صرح جوبيه ان مسالة يهودية الدولة يمكن ان تثير مشاكل لان في اسرائيل يهودا وعربا – بحسب تعبيره – واضاف ان لدى فرنسا والاورببين اجمالا رؤية علمانية للدولة لا تعرف الانتماء لها بالانتماء الى دين. غير ان حملة عنيفة شنتها المؤسسات اليهودية والدوائر المؤيدة لاسرائيل من مثل المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (كريف)، جعلته يتراجع في تصريح مشترك مع موراتينوس بالقول ان لديهم رؤية واضحة للحل دولتين، كل منهما دولة – امة: اسرائيل امة الشعب اليهودي، وفلسطين امة الشعب الفلسطيني.
تراجع لا مجال للدخول في تحليله هنا ولكنه لا يحتاج الى تحليل ليفسر لنا نفاق هذا الغرب ومنطق ان ما ينطبق على الامبراطورية لا ينطبق على البرابرة. فهناك رؤية علمانية ترسي مفهوم المواطنة وتصون الدولة – الامة، التي يتم تعريفها على اساس اجتماعي حضاري، وهنا رؤية دولة – امة على اساس ديني عنصري، ودعم للحركات الدينية، على اختلافها، والحركات العنصرية العرقية والاتنية على اختلافها، على حساب القوميين والعلمانيين. كما ليفسر لنا دعما فرنسيا اوروبيا لحركات معينة ولقوى معينة في الحراك الشعبي العربي، يخطىء الساج عندما يظنون انه دعم للتحولات الديمقراطية ولحقوق الانسان.