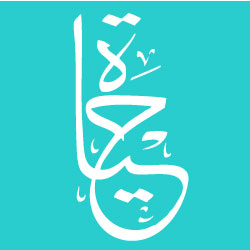في العام 1989 كان علييان: علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض يجلسان جنبا الى جنب في اخر مؤتمر قمة عربية عقد في بغداد. وفي خطابه امام المؤتمر حيا الرئيس العراقي الراحل صدام حسين هذه الثنائية الوحدوية طالبا الى سائر العرب الاقتداء بهما.
كان المؤتمر يناقش طلب اميركيا موجها الى العراق بتخفيض قواته المسلحة واجراء تحولات هيكلية اخرى على سياسته، وكان العراق يطالب الكويت ودول الخليج بالتوقف عن التضييق عليه بمسالة الديون والنفط. ويومها راى المتابعون شيئا من المبالغة والرومانسية في خطاب الملك الحسين عندما استشهد بالبيت الشعري المعروف: اضاعوني واي فتى اضاعوا.
بعدها بسنتين كانت رحلة الضياع الفعلي تبدا بحدة، تنجح في الكثير من مفاصلها وتفشل في الكثير: ضاع العراق، ضاعت فلسطين من جديد، ضاع الصمود العربي امام اسرائيل، ضاعت سيادة الخليج العربي على نفطه وارضه وبحاره، ضاع رفيق الحريري ليكون ضياعه الفردي، الذي لا يستحق ان يذكر مع ضياع اوطان، مدخلا لاضاعة لبنان وسوريا وما تبقى من قوى المقاومة الفلسطينية. ضاع الكثير وها نحن نشهد اخيرا خطر ضياع اليمن.
اليمن الذي قدم يومها نموذجا لوحدة ديمقراطية،وتطور بعد الوحدة الى التعددية الحزبية انزلق بعدها منزلقين خطيرين: الاول هو الحيف والغبن الذي اوصل البعض حد العودة الى الانقسام، واوصل البعض الاخر حد الفرض العسكري الوحشي، الذي شهدنا خلاله ( وقد شهدته شخصيا ) ممارسات لا يمكن ان يمارسها محتل مع شعب عدو. والثاني هو التحول من التعددية الى حكم الحزب الواحد، ففي بداية التسعينات بدا ان اليمن تسلك الطريق الحقيقي نحو التحول الديمقراطي، عندما اطلقت حرية تشكيل الاحزاب السياسية، التي تجاوز عددها العشرين ( وقد اعددت يومها ملفا عنها من 13 حلقة ) تبينت خلال العمل عليه ان جدلا فكريا وسياسيا حقيقيا ينطلق في الفضاء العام، مما يؤدي – على المدى البعيد الى تشكيل وعي سياسي واجتماعي، وخيار مبني عليه يؤسسان لنشوء راي عام.
صحيح ان الواقع القبلي الي يشكل اليمن كان معروفا ومستعصيا على التغيير المنظور، لكن التطوير البطيء كان ممكنا. رغم انه لم يكن من الصعب على من يزور الشيخ عبدالله الاحمر ان يدرك ان قبيلة حاشد اقوى من الدولة،( لتاتي بعدها القبائل الاخرى: عايد وبعض الاطراف الصغيرة التي لا قيمة لها ). لكن التعددية كانت موجودة، تعددية لم تلبث ان كانت اول ضحايا حرب الوحدة.
منذها – منذ حرب ما سمي بالوحدة – لم يكن لاي ممن شهدوا ما لحق بالجنوب من دمار وقمع وغبن وقهر ان يصدق ان هذه الوحدة ستدوم. ولم يكن لاي ممن عرفوا دواخل الفساد الاداري والسياسي للحكم القائم الا وان يتوقع انفجارات هنا وهناك، ولم يكن لاي مطل على الظروف الاقليمية الا وان يتوقع ان تلجا القوى الخليجية، والعربية الاخرى، والاقليمية الى مد اصابعها داخل الجسم اليمني المنهك والمتوتر. وداخل تلك البلاد التي اطلق عليها ادونيس بحق اسم: ” المهد ” والتي تكتسي فيما يتعدى الشعر اهمية جيوبوليتيكية وجيواقتصادية استثنائية بالنسبة للخليج العربي، لافريقيا، ولاسيا.
ويكفيك ان تنظر الى الخريطة لترى كيف تشكل هذه البلاد وبحارها مفتاحا اساسيا لكل تحرك عسكري وسياسي واقتصادي في هذه المنطقة. اما اذا عبرت الى التاريخ واكتشفت اية شبكة طرق قوافل كانت تحكمها اليمن بريا، وشبكة اخرى كانت تحكمها بحريا، لادركت لماذا لا يمكن للغرب ان يتركها وحالها، هي التي تتمتع باطول واغنى شواطىء بحرية عربية، واغنى معابر الى منافذ اقليمية ليس اقلها مضيق هرمز.
صحيح ان اليمن السعيد لم يعرف السعادة منذ امد طويل. ولكن كل ما عاناه قد يكون كله قليلا امام ما ينتظره. فليس التصريح الذي سمعناه قبل فترة من ان اليمن قد تحل محل افغانستان بالنسبة الى نشاط القاعدة،الا انذارا لا يجوز اخذه الا على محمل الجد. وليس تبرير ها التوقع بالتشابه الكبير بين اليمن وافغانستان من حيث الطبيعة الجغرافية والقبلية والمذهبية،وعلاقته الخاصة بالعربية السعودية الا جزءا من الحقيقة. من هنا لا يجوز النظر الى التمرد الحوثي كمجرد تمرد يكفي تدخل الطائرات السعودية لاخماده.كما انه لا يكفي الهجوم الاعلامي على دعاوى الانفصال الجديدة التي يسوقها علي سالم البيض لضمان المستقبل. الحل الوحيد لبلاد المهد هذه يكمن في اقتناع الحكم بالعودة الى ما شكل الحل في بداية التسعينات.