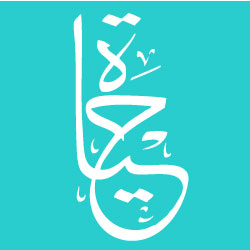“اليسار لا يعرف ان يدافع عن مبادئه ومارس تجربته السياسية على طريقة اليمين، لذلك ذهب الناخب الاسرائيلي مباشرة الى الاصل طالما ان الاخر تقليد له ”
بهذا فسر النائب العربي احمد الطيبي انتصار اليمين الاسرائيلي في الانتخابات الاخيرة. وقد يكون ذلك صحيحا من باب التحليل السياسي المباشر والتقليدي، لكن السؤال الاعمق الذي يطرحه التاريخ هو: متى كانت مبادىء اليسار الاسرائيلي مختلفة عن مبادىء اليمين فيما يخص الفلسطينيين والعرب، حتى ولو كانت هناك بعض الاصوات اليسارية القليلة التي تطرح طروحات مختلفة؟. حيث ان هذه الاصوات هي اولا من خارج اليسار الانتخابي، اي العمل وكاديما، وثانيا، اصوات نادرة وغير قادرة على التاثير في الواقع السياسي. دون ان يعني ذلك ان علينا اهمالها وعدم تشجيعها ودعمها، ولنرى كيف يفعل العدو مع اي شخص ينحاز اليه بيننا.
وفي واقع الامر ان فاعلية الكثير من هذه الاصوات قد برزت على الساحة الدولية لا الاسرائيلية، وخاصة خلال الازمة الاخيرة في غزة، وهذا ما يجب تفعيله، بعدة وسائل، افضلها فضح طبيعة النظام الاسرائيلي في هذا الغرب نفسه. فهناك تبدو الميزة الاساسية لاسرائيل لدى غالبية الجمهور انها، على علاتها دولة ديمقراطية حديثة في واحة من الدول الاحادية الشمولية المتخلفة. وليس من الصعب ابدا مواجهة هذا المنطق لو لجانا الى تفنيد القوانين الاسرائيلية نفسها وابراز التمييز العنصري الذي يمارس بحكمها. فتهمة العرقية اصبحت في اوروبا تهمة يعاقب عليها القانون، حتى بين الافراد. وتهمة التمييز بين المواطنين على اساس دينهم او اتنيتهم هي ابشع ما تخشاه اية دولة غربية. ومن هنا فان هذين السلاحين الفاعلين هما وللاسف صدئين تحت الخطاب العربي الذي يخاطب الغرب وكانه يخاطب جمهوره المحلي.
غير ان تبني هذا الطرح الذي يشكل اداة فاعلة في فضح الوجه الاسرائيلي امام الراي العام الغربي، يشكل في الوقت نفسه خطورة مهمة وهي تحويل القضية الى قضية مساواة في الحقوق المدنية، لا قضية ارض واحتلال وحق عودة. من هنا فانه من الذكاء التكتيكي ( لو كانت للقيادة الفلسطينية خطة واضحة ) ان يوكل هذا الامر لفلسطينيي الثامنة والاربعين، الذين يعيشون فيما يسمى دولة اسرائيل ويتجولون بجوازات سفر اسرائيلية، ويتعامل معهم الغرب كمواطنين اسرائيليين. في حين يترك للاخرين خطاب اخر.
لكن كل كلام طموح كهذا يظل حسرة اذا ما استمر الوضع الفلسطيني على ما هو عليه، حتى مع تسلم بنيامين نتنياهو للسلطة في اسرائيل. هذا الرجل الذي قد تكون حسنته الوحيدة بالنسبة للعرب انه لا يتقن الكتمان او حتى الديبلوماسية. وسيكون من الجريمة الا يدفع هذا التطور الاطراف الفلسطينية، ومن بعدها العربية الى حد ادنى من التوافق والمصالحات. مصالحات يجب ان تسوق اليها الحاجة ان لم يكن حسن النية. فالمعتدلون والممانعون، كرهما في مازق لا يعينهم على الخروج منه الا التوافق على الخطوط العريضة على الاقل.
ولنقارب الامور بصراحة، فنقول ان المعتدلين العرب هم الخاسرون الرئيسيون مع نتنياهو، لان علاقتهم باسرائيل هي اشبه بلعبة ( السيسو) التي يجلس فيها الاطفال كل على طرف خديدة او خشبة ، فاذا ما نزل واحد عن الطرف من جهته، نزل الاحر الى الارض حتما وسريعا.
صحيح ان حكومات العمل وكاديما لم تكن تعتلي طرف السيسو الا شكلا، وهي التي خاضت اسوا واشرس الحروب ضد العرب واخرها مغامرتي كاديما الدمويتين في لبنان 2006 وغزة 2008، ولكنها كانت تغطي هذه العدوانية الوحشية بقبلات وابتسامات ومصافحات تتبادلها مع قيادات السلطة الفلسطينية، ناسجة منها قناعا للحقيقة، يستعيره العرب جميعا.
نتنياهو لا يحب نسج الاقنعة، ولذلك فقد حرم اللاعبين المقابلين له منها. ووضعهم امام الحقيقة العارية.
بالمقابل فان حماس والمنظمات الفلسطينية الاخرى لا تستطيع ان تعيش قطيعة ابدية مع نصفها الاخر، والشعب الفلسطيني المدمى في غزة والمخنوق في رام الله بحاجة الى دفعة من الاوكسيجين تحمي وحدته الوطنية من الاختناق.
غير ان ثمة ما يربط اليد الفلسطينية هنا وهناك: ففي غزة التزام لا فكاك منه ازاء الناس الذين ضحوا بارواحهم واموالهم وعذاباتهم في اسوا محرقة شهدتها المنطقة،كما ان لدى حماس التزام لا فكاك منه ازاء امتداداتها في الضفة الغربية، ممن سيقوا الى السجن على يد اخوانهم لا على يد العدو، ولا تستطيع الحركة باي ثمن توقيع المصالحة على رؤوسهم. اما في رام الله فهناك التزام امام دايتون الذي ما يزال يشرف على خطته الامنية، ويطبق على عنق السلطة، وهناك التزام امام الدول المانحة التي تفرض شروطها مقابل اللقمة – ان لم نقل مقابل الجداول الثرة التي تتدفق الى جيوب الفاسدين الذين سيشكلون بدورهم عنصرا ضاغطا ضد المصالحة. كما ان هناك احقادا لا يمكن انكارها ازاء التجاوزات التي حصلت في غزة فيما سموه بالانقلاب.
لذلك فان الامر يحتاج الى جراة غير عادية. جراة من طرف حماس بالاعتراف بالاخطاء الفردية او الفئوية، والاعتذار لمن يستحق من اصحابها، ولديها الحجة القوية الان في ان الدم المراق على يد العدو قادر على غسل الدم او الحقد الذي تسببت به الاحداث. وجراة من طرف السلطة الوطنية الفلسطينية تتمثل في عدة ابعاد: التنصل من دايتون وخططه القاتلة، ومواجهة الدول المانحة بديبلوماسية وكرامة، ومواجهة الذات بابعاد الذين فاحت رائحة عمالتهم وفسادهم، والمبادرة الى اطلاق سراح السجناء السياسيين الذين ان هم الا مناضلون اشقاء. ولا يقولن احد ان هذا مستحيل التطبيق ، بدليل ان غزة عاشت بدون دايتون، وبدون الدول المانحة التي تستطيع الدول العربية والاسلامية ان تعوضها او تعوض ما ينقص منها.
فهل سيمتلك الطرفان هذه الجراة؟
وهل سيكون لنا ان نعود الى حلم الوحدة الوطنية لمن هم خارج اسرائيل كي نستطيع بعدها ان نفكر في كيفية الافادة ممن هم داخلها؟