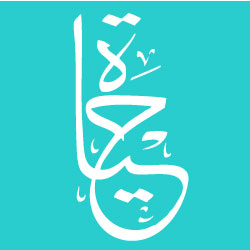الانفعال الذي تشهده الساحات الغربية ازاء الصور التي بثتها وسائل الاعلام، المرئي منها خاصة، لما يحصل في السجون الاميركية في العراق، يدفعنا بعد الانفعال المر الذي تدفعه القضية الى حلوقنا فيخنقنا الى التفكير مليا في اكثر من مسألة منها ما يتعلق بالسياسي ومنها ما يتعلق بالاعلامي.
انا الغارقة هذه الايام في بحر النظريات الاعلامية التي تدفقت على الغرب منذ بداية هذا القرن، بل ومنذ نهاية القرن الماضي، اجدني عاجزة عن ان اقارب أي فصل دون ان تقفز الى بالي السؤال: وهنا اين كنا نحن؟ ليليه سؤال آخر: والان: اين نحن؟
منذ 1789 والجدل الفكري قائم في اوروبا حول حرية تداول الافكار والمعلومات، ومنذ 1895 وغوستاف لو بون يؤسس للتمييز بين الجمهور والرأي العام، ليصل ليبمان عام 1922 الى ترسيخ مفهوم الرأي العام في كتاب حمل الاسم نفسه؟
اين كنا نحن؟ وهل كان ذنبنا ان ننتقل خلال ذلك من استعمار عثماني الى استعمار اوروبي؟
هل كان هذا الغرب، وهو يؤسس لحرياته قلقا بنا وبحرياتنا؟
هل كان ذنب ابي ان يضطر الى حمل قجته والرحيل الى المهجر بحثا عن لقمة عيش او عن لقمة كرامة؟ وهل قصر احرارنا منذها في رفع اعناقهم الى اعواد المشانق؟
واذا كان باحثو الاعلام يقسمون مراحل تطوره الى: قبل 1920، من 1920 الى 1940، من 1940 الى 1960، من 1960 الى 1980، اذن عشرون سنة لكل مرحلة، وفجاة يتغير الايقاع، فاذا بهم يقسمون من 1980 الى 1990 ومن 1991 الى 2001، أي عشرة عشرة. مما يؤشر الى ان ايقاع الحدث العالمي كله قد تغير،وتطور الانسانية قد تغير، فان عودة السؤال: اين نحن اين كنا نحن؟ يجعلنا نلحظ ببساطة ان العشرينات الاولى تقسمت على ايقاع الحربين العالميتين الاولى والثانية : ما قبلهما خلالهما وما بعدهما، في حين ان العشرات التالية قد تقسمت على ايقاع الحرب العالمية الثالثة التي لم تكن ساحتها اوروبا هذه المرة وانما ارض العرب بكامل رقعتها وتركزت في العراق قلبها.
كذلك نلحظ وبشكل واضح انه لا ذكر لنا، لا كوسائط اعلام ولا كعلماء وباحثين في هذ المعمعة البحثية التطبيقية التي تشكل سيلا كبيرا من العمل الدؤوب الميداني اكثر منه النظري والذي اسس في اوروبا انطلاقا من الدراسات القانونية (فرنسا) ومن الدعاية النازية ورافضيها (المانيا) كما انطلق بشكل رئيسي في اميركا من قضيتين: مسألة الاندماج المكون للامة ومسألة الاقناع الهادفة الى اقناع الاميركيين عامة والجنود بشكل خاص بالمشاركة في الحرب العالمية الثانية. بعد ذلك تركز العمل على مواكبة ودراسة العملية الديمقراطية الغربية خاصة عمليات الاقتراع، من لازارسفيلد وتلاميذه برلسون وكاتز، الى لاسويل ونظريته الخط الافقي للتأثير الاعلامي، الاشبه بالحقنة الوريدية، وما اثارته هذه النظرية من تيارات مؤيدة وتيارات رافضة حتى التسعينات.
هنا في التسعينات يبدأ رأس الدبوس العربي يطل، فما من باحث يستطيع الان تجاهل تأثير القنوات الفضائية وفي مقدمتها الجزيرة.
لكن السؤال الذي يظل مقلقا ان هذه الوسائط الاعلامية التي دخلنا بها العصر، وبشكل جيد تظل غير كافية لمنحنا موقعا ما على الخريطة الاعلامية الدولية، وذلك لسببين: الاول هو غياب عملية البحث المواكبة للعملية التطبيقية، وذلك ما يتجلى في عدم بروز اسم باحث عربي واحد الى جانب بروز عشرات الفضائيات.
والثاني مرتبط بالاول وهو ان عمليات البحث والتطبيق هذه يجب ان ترتبط بواقع التطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي على ارض الواقع العربي نفسه وهذا ما لا يتم اطلاقا، ولا تعوضه معرفة التيارات والنظريات الغربية.
صحيح ان عددا لا بأس به من الطلاب والباحثين العرب يعملون في الجامعات الغربية لكنهم يعملون ضمن الالة القائمة هناك، حتى ليتملك الواعين منهم الاحساس بان واحدنا يقوم طوال ثلاث سنوات، بعمل بحثي صعب، وعلى ارض بكر، ليقدم في النهاية رسالته هدية زاخرة بالمعلومات للمؤسسة الجامعية التي يعمل ضمنها، ومن خلالها للدولة التي تنتمي اليها.