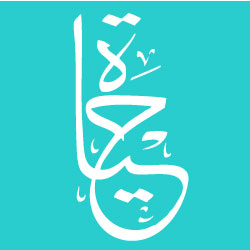عندما كان اللبنانيون يتنازعون اشلاء وطنهم باسم الطائفية والفئوية كان لمصطلح اللبننة دلالة سيئة، حولته الى فأل شؤم يهدد كل دولة او منطقة مرشحة للاقتتال الاثني والطائفي المدمر.
حتى ان جان بيير شفينمان وزير الدفاع الفرنسي المستقيل خلال حرب الخليج، جعل من مصطلح »لبننة العالم« عنوانا لاحد فصول كتابه »فكرة معينة عن الجمهورية تقودني الى…« حيث تحدث عن مخططات لاثارة تجزئة طائفية واثنية في العراق، ومخططات مشابهة تهيأ للدول العربية الاخرى، بل ولكثير من دول العالم الثالث، واوروبا الشرقية.
واذا كانت توقعات شفينمان قد شهدت تحققا جزئيا او كليا خاصة في البلقان التي افرد لها حيزا واسعا من التحليل. فان المصطلح اصبح سيفا يهدد الكثير من الدول العربية بدءا بالجزائر وامازيغها ووصولا الى مصر واقباطها، ومرورا بكثير من النيران المختزنة تحت الرماد للوقت الذي تقرر فيه الاطراف القادرة نفخ رياح التأجيج، لهدف او لآخر.
لكن المفاجأة، ان مصطلح اللبننة اتخذ معنى آخر، بعيدا كل البعد عن المشرط والتجزئة، عندما استعمله ارئيل شارون يوم امس لوصف تطورات الانتفاضة الفلسطينية، حيث قال: ان الانتفاضة تلبنن اسلوب عملها، في اشارة الى تصوير العمليات الفدائية بالفيديو.
سيكولوجيا، يمثل حضور المفردة هذه في القاموس الشاروني، وبدلالتها المذكورة، هاجسا استوطن في الذات الاسرائيلية هو هاجس لبنان، والعمليات اللبنانية، اشبه بما شكله هاجس فيتنام في السيكولوجيا الامريكية، هذا الهاجس الذي يعرف جميع المحللين انه يشكل مفتاح تفكير وزير الخارجية كولن باول، رغم مرور السنين الطويلة على انتهاء حرب فيتنام.
كذلك يمثل استعمال شارون للمفردة، في الحديث عن الانتفاضة اتساع دائرة الهاجس ليشمل العمليات في فلسطين.
ولا يعني ذلك اطلاقا ان ما يحصل الآن على الارض الفلسطينية، هو اول اعمال المقاومة، لكنه يثبت واقعا محددا وهو ان اسرائيل لا تعيش الهاجس الحقيقي العميق الا عندما تشعر ان ارواح اليهود في خطر لاسباب كثيرة، منها ما هو ايديولوجي تأسيسي ومنها ما هو واقعي عملي.
فالكل يعرف قيمة الحياة اليهودية في الايديولوجيا، وعدم كمون فكرة الموت والشهادة في اللاوعي الجمعي، لاسباب عقدية كثيرة.
وبناء على ذلك وعلى وقائع سياسية، لم تكن اسرائيل ابدا في ذهن المهاجر بقعة للنضال والشهادة والموت في سبيلها، وانما هي ارض اللبن والعسل، وجنة موعودة يجد فيها ما لم يجده في الاوطان التي هاجر منها، وكان يفترض به ان ينتمي اليها.
انها وعد بالرفاه والامان لا بتحدي الموت او على الاقل عدم الامان.
من هنا كان تركيز السياسيين الاسرائيليين الدائم، المتفق عليه، على الأمن كأولوية اولى، قبل السلام وقبل كل امر آخر.
وهذا ما كان بيريز يقصر الحديث عليه في القاهرة، بينما كان شارون يتحدث في تل ابيب عن اللبننة.
في الواقعي العملي ايضا ليس ما يحصل في فلسطين الا عملية عض اصابع، وكلما عض طرف اقوى، صر الثاني اسنانه اكثر، لتأتي النتائج السلبية لدى الطرفين: فيتحدث الفلسطينيون بخوف عن الهجرة، خاصة في صفوف العائدين من حملة الجنسيات الاجنبية، لكن هذا الخوف لا يبلغ ابدا ذاك الرعب الكامن لدى الاسرائيليين من فكرة الهجرة المضادة، وكل اسرائيلي تقريبا يحمل جنسية مزدوجة.
اضافة الى معادلة بسيطة وهي انه ورغم اضخم الهجرات من الـ 48 الى الـ ،67 لم يكن تناقص الوجود الديموغرافي سبب ضياع ما ضاع. في حين ان الوجود الاسرائيلي قائم على ترتيب هجرات مفتعلة، وبصعوبة.
لقد وجد الفلسطيني هناك بتلقائية، وجود كل شعب على ارضه، ويعود بذات التلقائية، بينما احتاج مجيء كل يهودي الى افتعال، وجهود مؤسساتية مضنية، وصفقات مكلفة..
هذا بالنسبة للهجرة، اما بالنسبة للخسارات الاقتصادية، فالوقائع والارقام تدل على ان تأثر الاقتصاد الاسرائيلي لا يقل ابدا عن تأثر الوضع الفلسطيني ان في قطاع السياحة او الصناعة او الخدمات او حتى التجارة.
ويبقى مجال الخطر المؤجل، التركيبة الداخلية، التي تتماسك بفعل الخطر وتظل مؤجلة الانفجار الى حين زواله.
هنا يكمن الرهان الاصعب..
وهنا يكمن الاستعمال الاصعب لمصطلح اللبننة.
فهل يستطيع الفلسطينيون الانتصار على التحدي الكبير في ترسيخ التعددية السياسية، في اطار وحدة لا خطر انفجارات فيها؟
وبهذا يرجحون كفة الميزان لصالحهم بامتياز، لأن تعدديتهم مقتصرة على الرؤى السياسية، في حين ان تعددية عدوهم هي فسيفساء اثنيات ولغات واصول واعراق، بل حتى قوميات واديان. في دولة لا تقوم الا على احادية الادعاء الديني ووهم ادعاء عرقي..
ان يختار الفلسطينيون بين لبننة حزب الله، ولبننة حزب الكتائب او لبننة جبهتي التحرير الوطني، والانقاذ الجزائريتين.
ذاك هو التحدي!.